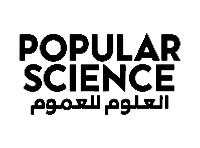هناك جدال يدور في وادي السيليكون بأن البشر سيعيشون عمراً أطول بكثير من أعمارهم اليوم. يقول بيل ماريس الذي كان يعمل سابقاً في شركة جوجل، إن البشر يمكن أن يعيشوا حتى 500 عاماً، بينما يرى مدير الصندوق الائتماني جون يون أن الرقم الصحيح هو ألف عام، في حين يرى آخرون، مثل مارتين روثبلات، مؤسس إحدى شركات التكنولوجيا الحيوية، أن الموت هو أمر اختياري. ولم يكن رواد الأعمال في وادي السيليكون أول من راودهم هاجس العمر المديد، فالأغنياء وذوو النفوذ في الكثير من المجتمعات يتطلعون إلى الخلود. ولكن التقدم الذي أنجز في الطب والتكنولوجيا خلال القرن المنصرم قد يمكِّن نخبة عالم التكنولوجيا من إحراز تقدم كبير على طريق إطالة عمر الإنسان.
هناك مشكلة واحدة فقط: وهي أن العمر الأطول لا يعني بالضرورة حياة أفضل. فعند حد معين، تتوقف أجزاء من الجسم عن العمل بشكل صحيح، مما يجعل الاستمتاع بهذه العمر الزائد أمراً عسيراً. وقد تُحوّل حالات مرضية مثل مرض ألزهايمر والسرطان والسكري وأمراض القلب والتهاب المفاصل السنوات الأخيرة من حياة المرء إلى معاناة. ولن يكون العيش لمدة ألف عام مليئاً بالنعم إذا كان المرء لا يتنعم بالصحة الجسدية سوى خلال أول 80 عاماً (أو حتى أول 900 عاماً).
ولحسن الحظ، يعمل بعض العلماء على إطالة الحياة الصحية للإنسان. وتبدو بعض التدخلات واقعية أكثر أو عملية أكثر من غيرها، ولكن أصبح من الواضح أن الإصابة بالأمراض مع التقدم في السن هو أمر لا مفر منه، وقد تغير هذه المقاربة حتى طريقة تفكيرنا في مفهوم الشيخوخة.
يقول ديريك هوفمان، أستاذ علم الأدوية الجزيئي والطب في كلية ألبرت أينشتاين للطب: “ليس هدفنا هو إطالة العمر على حساب كونه غير صحي لمدة 75 عاماً، ولكن هدفنا هو إطالة الزمن الذي نعيش فيه بصحة جيدة، وتقليص الزمن الذي نعيش فيه مع الأمراض”.
على أي حال، ما هي الصحة؟
يشير العلماء إلى عدد السنوات التي يتمتع فيها الفرد بصحة جيدة، على أنها العمر الصحي، ولكن القياس صعب. ويعتبر الشخص بصحة جيدة إذا كان الجسم يعمل بشكل عام بطريقة سليمة، مع عدم وجود علامات مرض. وليس من قبيل المصادفة أن السن هو أكبر عامل خطر للأمراض المزمنة، مثل مرض ألزهايمر والسكري وأمراض القلب. فمع تقدمنا في السن، وتدهور خلايانا، تتباطأ التفاعلات الكيميائية التي تتخلص من الفضلات، أو تحدث بوتيرة أقل، ويصبح هناك عدد أقل من الخلايا الجذعية لتحل محل الأنسجة المتدهورة.
وقد قضى الباحثون عقوداً من الزمن في محاولة لجعل حيوانات مثل القرود والفئران والديدان الإسطوانية تعيش لفترة أطول. كما حددوا بعض التقنيات التي تجعلها تعيش حياة صحية لمدة أطول. وبدءاً من ثلاثينيات القرن العشرين، أظهرت التجارب على الفئران أن خفض السعرات الحرارية بشكل كبير في نظامها الغذائي لا يطيل عمرها فحسب، بل يطيل أيضاً فترة بقائها بصحة جيدة (وقد تكررت النتائج عدة مرات، وكان آخرها في القردة).
يقول جوردون ليثجو، الأستاذ في معهد بَك لأبحاث الشيخوخة والمتخصص في آليات الشيخوخة: “تظهر العلامات التشريحية المرضية المرتبطة بمرض ما في فترة متأخرة عند الفئران التي تتبع نظاماً غذائياً محدود السعرات الحرارية، كما لا تصاب ببعض الأمراض أبداً، ومن هنا أتت – بحسب ليثجو- فكرة أن الحياة المديدة والصحة المديدة قد يتحققا معاً.
ومن خلال دراسات الحد من السعرات الحرارية، بدأ العلماء في تحديد عدد قليل من المسارات البيولوجية الرئيسية -وهي سلاسل من التفاعلات الكيميائية داخل الجسم – والتي من المرجح أن تلعب دوراً رئيسياً في الشيخوخة. وقد أشارت الدراسات إلى أن الحد من نشاط بعض هذه المسارات، كالمسار الذي يجعل هرموناً يسمى عامل النمو شبيه الإنسولين يتوافق مع النمو، في الحيوانات المسنة -ولكنها ذات صحة جيدة- يؤخرعلامات الشيخوخة. ويرتبط البعض الآخر، مثل بروتين الإشارات المناعية الذي يسمى إنتيرليوكين1، بالالتهابات، ويعتبرها رد فعل الجهاز المناعي المدمر على أنها تهديد. ويبدو أن الحد من المسارات التي تشير إلى وجود التهاب في الجسم، يقي الحيوانات من الشيخوخة.
وبطبيعة الحال، فإن البشر ليسوا فئراناً ولا قروداً، ولكن تظل النماذج الحيوانية هي مقصد الباحثين لمعرفة الكثير. يقول جيمس كيركلاند، أستاذ أبحاث الشيخوخة في مجموعة مايو كلينيك، إن بعض أنواع الإشارات لم تتغير كثيراً مع تطور البشر، وهذا رهان جيد بأنها ستعمل عند البشر”.
ويمكن أن تمنح التحاليل الوراثية للبشر المعمرين فكرة للباحثين عن النقطة التي ينطلقون منها في أبحاثهم. ولا يوجد الكثير ممن يعيشون فوق عمر المائة عام – فقد كشف إحصاء عام 2010 أن 53 ألف معمر فقط قد تخطوا عمر المائة عام في الولايات المتحدة الأميركية كلها- ولكن هناك الكثير من أولئك الذين يميلون للبقاء بصحة جيدة لمدة أطول مقارنة بغيرهم، ويميلون لأن يموتوا بسبب أمراض حادة مثل ذات الرئة، بدلاً من الأمراض البطيئة كالسرطان وأمراض القلب.
ولكن اختبار العلاجات المضادة للشيخوخة على البشر هو أكثر صعوبة بكثير من التحقق منها عند المعمرين. وتتطلب التجارب السريرية التي تقيس طول الحياة الصحية للبشر عقوداً من الزمن، ومليارات الدولارات، لذلك كان الباحثون يبحثون عن المؤشرات الحيوية للشيخوخة، وهي مؤشرات تُظهر لهم ما إذا كان تدخل معين يعمل بالطريقة التي كانوا يأملونها.
وعلى الرغم من عدم وجود بروتين واضح أو طفرة وراثية يمكن للعلماء الكشف عنها لإظهار الشيخوخة، فإن بإمكانهم أن يقيسوا أشياء مثل محيط البطن، وضغط الدم، وطول القسيم الطرفي (وهو منطقة من تسلسل نووي كثير التكرار يتوضع عند نهاية الكروموسومات)، ومؤشر كتلة الجسم، ومؤشر الضعف، للوصول إلى العمر الفيسيولوجي للشخص .
لقد اتفق المجتمع العلمي بدرجة ما على أنواع المسارات التي تلعب دوراً رئيسياً في الشيخوخة والأمراض المتعلقة بها، لكنه أبعد ما يكون عن التوصل إلى توافق بشأن أفضل السبل لتغييرها.
التدخلات
أظهرت سنوات من التجارب على الحيوانات أن تقييد السعرات الحرارية هو وسيلة فعالة غير جراحية لإبطاء العلامات الحيوية للشيخوخة. لكن، باستثناء عدد قليل من المجتمعات الصغيرة من الأشخاص الخاضعين لتقييد السعرات الحرارية، فإنه من الصعب إقناع الناس بتجاوز رغبتهم الحيوية في تناول ما يكفي من الطعام ليشعروا بالامتلاء. وهناك أدلة جيدة على أن التمارين الرياضية يمكن أن تبطئ الشيخوخة أيضاً، ولكن التمارين وحدها ليست كافية لإحداث تأثير كبير.
ويمكن للتدخلات الدوائية أن تناسب بسهولة أكبر أنماط حياة الناس، ولحسن الحظ، هناك عدد قليل من الأدوية ذات التأثير الواعد. يشير كيركلاند إلى أن هناك خمسين دواءاً تؤثر على المسارات المناسبة، مع الدراسات المحكمة علمياً على أكثر من عشرة منها. وقد تم طرح أحدها في الأسواق لسنوات – ويدعى ميتفورمين- كعلاج رخيص للنوع الثاني من الداء السكري. وقد أظهرت عدة تجارب، بما فيها تلك التي أجريت على الفئران، أن هذا الدواء هو خيار واعد لمكافحة الشيخوخة.
كما وجدت دراسة تعود لعام 2014 أن مرضى السكري الذين يتناولون الميتفورمين يعيشون عمراً أطول لا يزيد على أعمار مرضى السكري الآخرين الذين لا يتناولون الدواء وحسب، ولكنه يزيد أيضاً على أعمار غير مرضى السكري ممن لم يتناولوا الدواء. ويقوم الباحثون الآن باختبار الميتفورمين كدواء يكافح الشيخوخة، في أول تجربة سريرية معتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء.

حقوق الصورة: ديبوزيت فوتوس
وقد أظهرت تجربة أخرى على دواء يسمى “رابامايسين”، الذي تم تطويره أساساً لكبح الجهاز المناعي بعد زرع الأعضاء، نتائج مذهلة في الفئران والكلاب. ولكن له آثاراً جانبية أكثر، مثل زيادة خطر الإصابة بالداء السكري من النوع الثاني. وعلاوة على ذلك، فإن العديد من الأدوية التي وجدت لتعمل على الفئران، تُظهر الكثير من الاختلاف بين الأفراد، بل حتى يبدو أنها تؤثر على ذكور وإناث القوارض بشكل مختلف، مما يجعلها خيارات أقل جاذبية للتجارب البشرية.
وقد حظي التعايش الالتصاقي، وهو تجربة تعود لعقود من الزمن يربط فيها العلماء الأنظمة الدورانية للقوارض الصغيرة والمسنة، بمزيد من الاهتمام فى السنوات القليلة الماضية بفضل الملياردير بيتر تييل الذي قال لمجلة “إنك” Inc إنه مهتم بحقنات من الدماء الشابة لإطالة أمد الحياة الصحية للبشر. ولكن على الرغم من أن التجارب السريرية المثيرة للجدل خلصت مؤخراً إلى أن الدماء الشابة يمكن أن يكون لها آثار مضادة للشيخوخة، فإن معظم الباحثين، بمن فيهم هوفمان، يرون أن التعايش الالتصاقي هوأداة تجريبية لمعرفة أهداف جديدة لمكافحة الشيخوخة من أجل التوصل إلى عقار مستقبلي، وليس علاجاً بحد ذاته.
وبالنظر إلى المستقبل البعيد، فقد تكون الهندسة الوراثية باستخدام أدوات مثل تقنية كريسبر (تقنية التكرارات العنقودية المتناوبة منتظمة التباعد) أحد الخيارات لإطالة الحياة الصحية. لكن الآفاق بعيدة جداً – وبالتالي فهي محفوفة بمشاكل أخلاقية- ولذلك لا يمكن للباحثين النظر فيها بجدية. يقول مات كايبرلاين، أستاذ علم الأمراض في جامعة واشنطن: “من السابق لأوانه الحديث عن تقنية كريسبر، لأن أحداً لم يجربها حتى الآن على حيوانات المختبر، وأعتقد أنه من غير المسؤول أن نتحدث عن تجريبها مع البشر”.
ويرى آخرون أنه من الأفضل البدء في إجراء تلك المحادثات الصعبة في وقت مبكر، يقول ليثجو: “إنها مسألة جيدة حقاً من الناحية الأخلاقية. إذا كنا نستطيع أن نقوم بالهندسة الوراثية اليوم، وكانت ستؤثر على الجيل القادم، فهل ستقوم بها؟ ما لم نفهم هذه المفاضلات، لن نتمكن من هندسة الجيل القادم وراثياً”.
ومع ذلك، فإن البعض في هذا المجال متشككون في أن هذه التدخلات ستعمل كما هم مؤمل منها. ويقر لويجي فونتانا، أستاذ طب الشيخوخة وعلم التغذية في جامعة واشنطن في سانت لويس، بأدلة تقييد السعرات الحرارية وآثار ممارسة الرياضة، لكن الهندسة الوراثية غير واقعية، كما يقول، والميتفورمين هو مجرد “هراء”. ويضيف: “هذا هو التفكير المتعمد عند الناس الذين يبيعون الأوهام”.
وحتى في مجال البحوث المتعلقة بالشيخوخة، يبدو من الصعب تحقيق توافق في الآراء. يقول هوفمان: “عندما تجري محادثات في هذا المجال، فإن الجميع لديهم تحيز، ويقولون إنهم يعتقدون أن هذا المسار أو هذا العامل هو الأكثر أهمية، هذه هي مشكلة هذا المجال حالياً”. ولكن في الأساس، فإن هؤلاء الباحثين جميعاً لديهم نفس الهدف، وهو جعل البشر يعيشون حياة صحية لفترة أطول، وقد تفتقر مهمتهم هذه فقط إلى بطل، وعمل جماعي.
تحول في مفهوم الطب الذي نعرفه
ومع عمل الباحثين على تطوير واختبار طرق لإبطاء الشيخوخة، سينظرون أولاً إلى إيجاد علاجات مخصصة لأشخاص بأعمار الخمسينات والستينات، حيث تبدأ غالباً في هذه المرحلة من العمر الأمراض المزمنة بالظهور. ويجب أن تستغرق الدراسات التي تقيم تلك العلاجات، والتي تم التخطيط لبعضها بالفعل، بضعة أشهر أو سنوات (التجارب على الميتفورمين بشكل خاص)، وذلك لقياس المؤشرات الثانوية مثل مؤشر كتلة الجسم والضعف بدلاً من الموت نفسه لضمان فعاليتها، وفي نهاية المطاف، قد يكون هناك أدوية يبدأ الناس بتناولها وهم في سن أصغر.
ولكن إقناع الأصحاء بتناول أدوية هو أمر صعب، فبدون تجارب سريرية طويلة الأمد، من المستحيل توقع كيفية تأثير استخدام عقار مضاد للشيخوخة على مدى عقود على جوانب أخرى من الصحة على المدى الطويل. سيكون هناك حتماً بعض الآثار الجانبية، وسيضطر الجمهور إلى الدخول في نقاشات حول جدوى ذلك. يقول كايبرلاين: “كل من يقول لك إنه لا يوجد خطر للتدخل، فهو يكذب عليك”، ويضيف أن هناك أشخاصاً يتساءلون عما إذا كانت التجارب السريرية اللازمة لإثبات سلامة وفعالية هذه العلاجات هي أخلاقية أصلاً.
وتشير هذه القضايا إلى عقبة أيديولوجية أعمق تمنع العلاجات المضادة للشيخوخة من أن تصبح شائعة، ففي الوقت الراهن، يعتمد نظامنا الطبي على البحث عن علاجات للحالات الطبية عند ظهورها، بينما يعني طرح تدخلات لعلاج الشيخوخة في السوق تحولاً أساسياً في نظامنا الطبي، نحو الطب الوقائي. يقول كايبرلاين: “لقد تم تدريبنا في الطب الحيوي للتركيز على المرض بدلاً من الصحة، ولهذا فإن التحول النموذجي سيستغرق وقتاً”. ويضيف كايبرلاين بأنه ولكي ننتقل من النجاح في المختبر إلى إحداث تأثير فعلي على رفاهية الإنسان، فإنه يجب أن يكون لدينا رأي عام يقف إلى جانبنا.
ويمكن أن يمهد القبول الاجتماعي لتدخلات الشيخوخة الطريق أمام التحول الطبي، حيث يعاني مجال البحوث المضادة للشيخوخة مما يسميه كايبرلاين “مشكلة سمعة”، فعلى مدى عقود، ادعت شركات تنتج سلسلة من كريمات الجلد إلى المكملات العشبية، أن لها خصائص “مكافحة للشيخوخة”، مع عدم وجود سند علمي لها. يقول كايبرلاين: “يربط الناس مجالنا بزيت الثعبان، وهذا يعزز التصور الشائع عن أن مجالنا غير دقيق، إضافة إلى أن الناس لا يستثيغون بشكل عام الحديث عن الشيخوخة والموت.
في الوقت الراهن، لا يزال الباحثون يحاولون الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فهي حتى الآن لا توافق سوى على علاجات لحالات طبية محددة، فعلى سبيل المثال، تمت الموافقة لأول مرة على عقار “بروزاك” كعلاج للاكتئاب، وعقار “ليبيتور” لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية. ويحاول الباحثون في مجال الشيخوخة اليوم إقناع الإدارة بمنح تعيينات مستقلة للطب الوقائي.
ومن وجهة نظر إدارة الغذاء والدواء، فإن المجال الطبي المبني على أساس مكافحة الشيخوخة لا يزال في مهده، حيث يعلق أحد المتحدثين باسم الإدارة: “إن السؤال الذي لم تتم الإجابة عليه بعد، هو كم عدد الأمراض المرتبطة بالشيخوخة من غير الأمراض المستقلة (كمرض الشريان التاجي، والخرف، وضمور اللحم، وما إلى ذلك)، والتي نرى أنها تحتاج إلى تحسين، لاعتبار التأثير العلاجي تأثيراً “مضاداً للشيخوخة “، بدلاً من كونه تأثيراً على أمراض محددة. ومن الجدير بالذكر مرة أخرى، أن أي دواء يحسن من هذه الظروف سيكون قيماً جداً، ولا يزال من الصعب أيضاً معرفة كيفية قياس ما إذا كانت هذه التدخلات فعالة أم لا، ويضيف المتحدث: “إن إدارة الغذاء والدواء تتطلع إلى رؤية هذا المجال العلمي يتطور”.
يقول هوفمان: “إذا كان هذا المجال سيمضي قدماً في الوصول إلى أدوية لعلاج الشيخوخة عند البشر، فسنحتاج إلى خط اتصال مباشر وموثوق من إدارة الغذاء والدواء للقيام بذلك”. ومن شأن وجود هذا الإطار – وفقاً للباحثين- أن يدفع بالابتكار إلى الأمام. ويمكن تخصيص المزيد من الأموال البحثية للوقاية، وستعمل شركات الأدوية على تطوير أدوية جديدة يمكن أن يستخدمها جميع السكان البالغين. وعلى الرغم من أن كيركلاند لا يعتقد أنه سيكون هناك تعيين خاص للتدخلات المضادة للشيخوخة في أي وقت قريب، فإنه يقول إن إدارة الغذاء والدواء كانت داعمة ومشجعة في مجال عملهم. ويمكن لمسار واضح لإدارة الغذاء والدواء، بالإضافة إلى وجود خطاب عام شفاف، أن يعطي هذا المجال سمعة تتناسب مع العلوم الصارمة التي تقود مسيرة البحث العلمي بالفعل.
وستبرز نقاط أخرى تحتاج للتفكير بها، فعلى الرغم من أن وجود أشخاص يعيشون حياة صحية أطول سيعود بالنفع على الاقتصاد ويخفض الأعباء على نظام الرعاية الصحية، لكن قد يحدث تفاوت بين الطبقات الاجتماعية والاقتصادية، حيث لا يستطيع الإنفاق على إطالة العمر سوى الأغنياء (وهذا هو الحال بالفعل، ولكن قد يصبح التفاوت أكثر وضوحاً). وعندما يعيش البشر لفترة أطول، يمكن أن تظهر أمراض جديدة، وهذه ليست مشكلة افتراضية، فعلى امتداد القرن الماضي الذي انخفضت فيه معدلات أمراض القلب والسكتات الدماغية، أصبح مرض ألزهايمر شائعاً أكثر فأكثر. يقول ليثجو: “من المستبعد جداً أن نرى أي شخص خلال العصر الحجري مصاب بمرض ألزهايمر”. ولكن عندما بدأ الناس يعيشون حياة أطول، كان هناك المزيد من الوقت لتظهر وتتراكم مشاكل جسدية معينة، ومن المرجح أن يُظهر لنا الجينوم البشري المزيد من المفاجأت.
ولكن هذا ليس سبباً للتوقف، يقول كايبرلاين: “حتى لو كانت هناك سلبيات، لا أرى ذلك حجة كافية لعدم إجراء البحث”.
ويبدو أنه من المرجح على نحو متزايد أن تظهر تدخلات جديدة لجعل الناس يعيشون حياة صحية أطول. يقول كيركلاند: “قبل ثلاثين عاماً، كنت سأقول إن إيجاد وسيلة لإطالة الحياة الصحية تملك فرصة للنجاح بنسبة خمسة في المائة، ولكن هذه النسبة ارتفعت اليوم إلى 25 في المائة، وسترتفع كل عام أكثر من العام الذي سبقه”.
وسيعتمد كون هذا العلاج الوقائي جاهزاً للاستخدام على نطاق واسع، على مدى سرعة حدوث هذه التحولات، لكن الباحثين يقومون بتتظيم خطوات عملهم من النواحي العلمية والتنظيمية والاجتماعية.
والسؤال الحقيقي بالطبع هو ما إذا كان الأفراد على استعداد للعيش لفترة أطول بكثير، والموت في عوالم مختلفة جذرياً عن تلك التي ولدوا فيها، وبالنظر إلى رغبة البشر الدائمة في الحياة الأبدية، فمن غير المرجح أن يفرط الكثيرون بهذه الفرصة، أما ما الذي سنفعله بهذه الفرصة، وهل ستجعلنا سعداء أم لا، فتلك قضية أخرى تماماً.