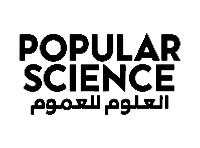قمت في العام الماضي بزيارة متحف الإرميتاج في سان بطرسبرج بروسيا، والذي يعدّ أحد أفضل المتاحف الفنية في العالم. كنت أتوقع أن أستشعر روائعه الفنية بكل صفاء ذهن، ولكن تم تشويش المنظر من قبل مجموعة كبيرة من الهواتف الذكية التي تلتقط الصور للوحات. وعندما تمكّنت من العثور على القليل من المساحة الفارغة، كان هناك أشخاص يلتقطون صور السيلفي للاحتفاظ بذكريات دائمة لزيارتهم.
بالنسبة للكثير من الناس، أصبح التقاط المئات -إن لم يكن الآلاف- من الصور جزءاً حاسماً من رحلات الإجازات، بهدف توثيق كل التفاصيل الأخيرة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن كيف يؤثر ذلك على ذكرياتنا الحقيقية للماضي وعلى طريقة رؤيتنا لأنفسنا؟ بصفتي خبيرة في مجال الذاكرة، فقد كنت أشعر بالفضول.
لسوء الحظ، فإن الأبحاث النفسية حول هذا الموضوع ضئيلة جداً، لكننا نعرف بعض الأشياء. فنحن نستخدم الهواتف الذكية والتقنيات الجديدة كمخازن للذكريات. ولا يعدّ هذا بالأمر الجديد، فدائماً ما استخدم البشر الأجهزة الخارجية كوسائل مساعِدة لاكتساب المعرفة والذاكرة.
إن الكتابة تخدم بالتأكيد هذه الوظيفة. فالسجلات التاريخية هي عبارة عن ذكريات خارجية جماعية. وتساعد شهادات الهجرات أو الاستيطان أو المعارك دولًا بأكملها على تتبّع نسبها وماضيها وهويتها. وفي حياة الفرد، يقوم التدوين في دفاتر اليوميات بوظيفة مماثلة.
تأثيرات الذاكرة
نميل في الوقت الحاضر إلى الاحتفاظ بالقليل جداً من الذكريات، فنحن نوكل كمية كبيرة منها إلى التخزين السحابي. ولا يقتصر الأمر فقط على القصائد التي نريد أن نسمعها، بل حتى أن معظم المناسبات الشخصية عموماً يتم تسجيلها على الهواتف المحمولة. وبدلاً من أن نتذكر ما نأكله في حفل زفاف أحد الأشخاص، فإننا نذهب لننظر إلى الصور التي التقطناها للطعام.
لهذا الأمر عواقب خطيرة. إذ تبيّن أن التقاط الصور لمناسبة ما بدلاً من الانغماس فيها يؤدي إلى قدرة أضعف على استعادة ذكريات المناسبة الفعلية، لأننا نتعرّض للتشويش خلال هذه العملية.
كما أن للاعتماد على الصور من أجل التذكّر تأثير مماثل. إذ يجب استخدام الذاكرة بشكل منتظم حتى تقوم بوظيفتها بشكل جيد. وهناك العديد من الدراسات التي توثّق أهمية ممارسة استعادة الذكريات، لطلاب الجامعات على سبيل المثال. إذ تعتبر الذاكرة ضرورية للتعلّم وستظل كذلك. وهناك بالفعل بعض الأدلة التي تثبت أن الاحتفاظ بكافة المعارف والذكريات في وسائل التخزين السحابي قد يعيق القدرة على التذكّر.
ومع ذلك، هناك جانب مشرق. فحتى لو ادّعت بعض الدراسات بأن كل ذلك يجعلنا أكثر غباءً، فإن ما يحدث في الواقع هو تغيير المهارات من مجرد القدرة على التذكّر إلى القدرة على إدارة الطريقة التي نتذكّر بها بشكل أكثر كفاءة. يُدعى هذا الأمر بما وراء المعرفة، وهو مهارة شاملة وضرورية أيضاً للطلاب، عند تخطيطهم لما يدرسون وكيف يقومون بذلك، على سبيل المثال. هناك أيضاً أدلة كبيرة وموثوقة على أن الذكريات الخارجية -بما فيها صور السيلفي- يمكنها أن تساعد الأفراد الذين يعانون من ضعف الذاكرة.
ولكن في حين يمكن للصور أن تساعد الناس على التذكّر في بعض الحالات، إلا أن نوعية الذكريات قد تكون محدودة. فقد نتذكّر ما يبدو أكثر وضوحاً، ولكن هذا قد يكون على حساب أنواع أخرى من المعلومات. وأظهرت إحدى الدراسات أنه على الرغم من أن الصور يمكن أن تساعد الأشخاص على تذكّر ما رأوه خلال بعض المناسبات، إلا أنها أدّت إلى تقليل ذكرياتهم عمّا تم ذكره.
هل يعدّ ذلك تشويهاً للهوية؟
هناك بعض المخاطر الشديدة عندما يتعلق الأمر بالذكريات الشخصية. إذ أن هويتنا هي نتاج تجارب حياتنا، والتي يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال ذكريات الماضي. فهل يؤدي التوثيق الفوتوغرافي المستمر للخبرات الحياتية إلى تغيير كيفية نظرنا لأنفسنا؟ لا يوجد أي دليل مادي على هذا حتى الآن، لكنني أعتقد بأنه يقوم بذلك.
من المرجح أن تجعلنا الكثير من الصور نتذكّر الماضي بطريقة ثابتة، مما يحجب الذكريات الأخرى. وفي حين أنه من غير النادر أن تستند ذكريات الطفولة المبكرة على الصور بدلاً من الأحداث الفعلية، إلا أنها ليست ذكريات حقيقية دائماً.
مسألة أخرى هي الحقيقة التي كشفت عنها الأبحاث في افتقار صور السيلفي والعديد من الصور الأخرى إلى العفوية. إذ يتم التخطيط لها ووضعياتها ليست طبيعية ويتم تشويه صورة الشخص في بعض الأحيان. كما أنها تعكس نزعة نرجسية تُظهر الوجه بتعابير غير طبيعية، كالابتسامات العريضة المصطنعة وحركات الفم الشهوانية والوجوه المضحكة والإيماءات البغيضة.
والأهم من ذلك هو أن صور السيلفي والعديد من الصور الأخرى هي صور عامة للمواقف والنوايا والسلوكيات الخاصة. وبعبارة أخرى، فإنها لا تعكس حقيقة ما نحن عليه، بل تعكس ما نريد أن نُظهره للآخرين حول أنفسنا في تلك اللحظة. إذا اعتمدنا بشكل كبير على الصور في تذكّر ماضينا، فقد نقوم بإنشاء هوية ذاتية مشوّهة بناءً على الصورة التي نريد إظهارها للآخرين.
ومع ذلك، فإن ذاكرتنا الطبيعية ليست دقيقة تماماً في الواقع. إذ تُظهر الأبحاث بأننا غالباً ما نخلق ذكريات خاطئة عن الماضي. نحن نفعل ذلك من أجل الحفاظ على الهوية التي نريد أن نحصل عليها مع مرور الوقت، وكذلك تجنب القصص المتضاربة حول ما نحن عليه. فإذا كنت دائماً رقيقاً ولطيفاً نوعاً ما، ولكنك قررت بأنك قاسٍ من خلال بعض الخبرات الحياتية الهامة، فقد تبحث عن الذكريات العدوانية في الماضي أو قد تختلقها بالكامل.
إن وجود العديد من الذكريات اليومية على الهاتف عن الطريقة التي كنا فيها في الماضي قد يجعل ذاكرتنا أقل مرونة وأقل قابلية للتكيّف مع التغيّرات التي أحدثتها الحياة، مما يجعل هويتنا أكثر ثباتاً واستقراراً.
لكن هذا يمكن أن يخلق مشاكل إذا أصبحت هويتنا الحالية مختلفة عن هويتنا الثابتة السابقة. تعدّ هذه تجربة غير مريحة، وهي بالضبط ما تهدف الوظيفة "الطبيعية" للذاكرة إلى تجنبه، فهي مرنة حتى نتمكّن من الحصول على قصص غير متضاربة حول أنفسنا. نحن نريد أن نفكر في أنفسنا بأن لدينا "جوهراً" ثابتاً لا يتغير. وإذا شعرنا بعدم القدرة على تغيير الطريقة التي نرى بها أنفسنا مع مرور الوقت، فقد يؤثر هذا بشكل خطير على إحساسنا بالتمثيل وعلى صحتنا العقلية.
وبالتالي، فقد يكون هاجسنا في التقاط الصور سبباً في فقدان الذاكرة وتناقضات الهوية غير المريحة.
من المثير للاهتمام التفكير في الكيفية التي تغيّر بها التكنولوجيا من الطريقة التي نتصرف ونعمل بها. وطالما أننا على دراية بهذه المخاطر، فيمكننا على الأرجح تخفيف الآثار الضارة. إن الاحتمال الذي يصيبني فعلاً بالذعر هو أننا نفقد كل تلك الصور الثمينة بسبب إساءة الاستخدام واسعة النطاق لهواتفنا الذكية.
لذلك في المرة التالية التي تزور فيها المتحف، قم بتخصيص بعض الوقت للتأمّل فيه والإحساس به، تحسّباً لفقدان تلك الصور.