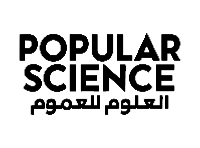يناقش المواطنون وواضعو السياسات في جميع أنحاء العالم كيفية الحد من استغلال الشركات للبيانات الشخصية، وكيفية تقييم درجة خصوصية البيانات المختلفة، لكن علماء الأنثروبولوجيا، مثلي، يعرفون أن الثقافات تختلف اختلافاً كبيراً في وجهة نظرها حول ما يمكن اعتباره خصوصيةً، ومن المسؤول عن حماية الخصوصية. ويمكن أن يختلف مفهوم الخصوصية من شخصٍ إلى آخر في العالم الواقعي ومن موقفٍ إلى آخر، وكذلك الأمر في العالم الافتراضي أو عالم الإنترنت.
تبدأ معظم مفاهيم الخصوصية لدينا بجسمنا المادي؛ فقد وجد علماء الاجتماع أن كلَّ شخصٍ لديه مساحة حميمية، تحيط بجسده وقريبة منه، يشعر فيها بالأمان، ولا يشعر بالراحة عند تجاوزها، وبعدها مساحة شخصية أوسع، ثم مساحة اجتماعية، وأخيراً منطقة عامة.
يتفاوت حجم هذه المساحات ومتانة الحدود بينها باختلاف الثقافات؛ فعلى سبيل المثال، يتمتع المكسيكيون بمناطق حميمة أصغر من الأميركيين؛ لذلك عندما يتكلم المكسيكي سيقترب أكثر محاولاً تجاوز مساحة الأميركي الشخصية، وسيعتبر الأميركي ذلك تجاوزاً للحدود المسموح بها، كأنه غزوٌ للفضاء الحميم الخاص به؛ فيحاول الابتعاد تلقائياً، لكن المكسيكي سيتصور أن هذا التراجع يعبر عن مشكلة ما، فيحاول الاقتراب مجدداً. يمكن أن يشعر الناس بسهولةٍ بالتهديد أيضاً في الأماكن المزدحمة، حيث يقترب الغرباء من مساحتهم الشخصية الحميمية.

تُحدد العديد من الثقافات أيضاً مساحات الخصوصية تبعاً لمناطق الجسم، وأنواع الأشخاص المسموح لهم بالاتصال الجسدي؛ فعلى سبيل المثال، يتصافح الأصدقاء في العديد من الثقافات، ويلامس كل منهم وجه الآخر للتحية، بينما تقتصر تلك التصرفات في ثقافاتٍ أخرى على الشركاء الرومانسيين.
أضف إلى ما تقدّم أن المواد الجسدية؛ مثل: اللعاب، والبول، والأظافر، والشّعر، عادة ما تكون شديدة الخصوصية. هناك العديد من الثقافات التي يعتقد فيها الناس أنَّ بإمكانهم استخدام هذه المواد «بطريقةٍ ما» لتحلَّ اللعنة على شخصٍ ما، أو لقتله، وفي بعض الثقافات الأخرى يشير السماح لشخص ما بملامسة هذه الأشياء إلى أنهم يثقون فيه ثقةً عمياء، وهذا ما يفسِّر أن البعض في أفريقيا يبصقون في راحة يدهم قبل المصافحة، وكان ذلك شائعاً في الولايات المتحدة أيضاً في الماضي.
ما الذي يحدد الخصوصية؟
عشتُ بين عامي 1979 و 1980 في قرية «كيكشي مايا» جنوب بليز، هندوراس البريطانية سابقاً، حيث رأيت نوعاً مختلفاً من الخصوصية لم يسبق لي أن رأيته؛ إذ كانت النساء الأكبر سناً تخرجن شبه عاريات، ولم يكن أحدٌ ما ينظر إليهن، وتعيش العائلات الكبيرة العدد في غرفةٍ واحدة، مع كل ما يتضمنه ذلك في تصورنا من انتهاكٍ للخصوصية.
كانت منازلهم مصنوعة من ألواح منحوتةٍ باليد والعصي، ومليئةً بالثغرات والشقوق؛ لذلك كان من الممكن لأي شخصٍ اختلاس النظر للداخل، إذا أراد، لكنهم لا يفعلون ذلك، وكانت العادة لديهم بأن يقف الشخص على بُعد 20 قدماً تقريباً من الباب، وينادي سائلاً: «هل يوجد أحد بالمنزل؟». يمكنك الدخول إلى المنزل فقط إذا دُعيتَ إلى ذلك، وكوني رجلاً غريباً عنهم، فقد استُثْنِيت من هذه العادات، وكنت أستيقظ كلَّ صباحٍ على أصوات ثرثرة تلاميذ المدارس الذين يسترقون النظر عبر جدران منزلي؛ ليروا كيف يعيش الرجل الأبيض.
وقد لاحظت شيئاً مماثلاً عندما كنت أعيش في أمستردام عام 1985، لقد شعرت بالصدمة؛ لأن معظم طوابق المباني الأرضية والمنازل لا تحتوي على ستائر، ويمكن للمارة النظر مباشرةً إلى غرفة معيشة شخصٍ ما، أو إلى غرفة طعامه.
أخبرني الناس هناك بأنهم لا يشعرون، كأنهم يعيشون في حوض سمك؛ لأنهم لا يتوقعون أن يسترق النظر أي شخص، ولن يعترف أحدٌ طبعاً بأنه استرق النظر ذات مرة، وفي الواقع لستُ مضطراً للتستر وإخفاء أي سلوكٍ طبيعي، ما دمت تستبعد أن يختلس النظر أحدٌ ما، وإنْ كان شخصٌ ما يراقب خلسةً، فلن يُصرِّح بذلك.
توضح هذه الأمثلة أنه من الممكن، دون جدران، ألا تشعر بأن أحداً ما يراقبك، وأن أفعالك ستبقى سريةً، وإن رآك أحدهم، فلن يستطيع التصريح بذلك أمام الآخرين، ما دام المجتمع متمسكاً بمعايير السلوك العام، ويفرض عواقب اجتماعية على أي انتهاكات لهذه الخصوصيات.
تغيّر المعايير
تغيرت معايير الخصوصية في أميركا الشمالية وأوروبا كثيراً في العقود الأخير؛ فقد كانت الأُسر تعيش سابقاً في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر معاً في غرفةٍ واحدة، وكان أفراد العائلة يتقاسمون الأَسِرَّة عند النوم، وكان المسافرون في بدايات استعمار أميركا يتقاسمون الأَسِرَّة مع الغرباء في الفنادق.
لم يدم ذلك طويلاً؛ فقد بدأت تسود فكرة أنه ينبغي أن يكون لكل طفلٍ في الولايات المتحدة غرفته الخاصة، في بداية القرن الماضي، وأنه ينبغي الفصل بين الذكور والإناث. وفي الواقع لم يكن لدى الكثيرين -حتى فترة الخمسينيات والستينيات- إمكانية شراء منازل بمساحةٍ كبيرة لتحقيق هذا الغرض، وما زال الكثيرون لا يستطيعون تحمّل تكاليفها حتى الآن، وهناك العديد من الآباء يفضلون أن ينام أطفالهم معهم.
تميل معايير الخصوصية المُثلى إلى التغير ببطءٍ عموماً؛ فعندما تزداد مساحة منازل الأميركيين، يحصل الأطفال الأكبر سناً على غرفةٍ خاصةٍ بهم، أو شقة منفصلة، ومع ذلك لا تزال الخصوصية الممنوحة للأطفال، والمراهقين، وكبار السن، موضع جدالٍ، ولا تزال الخلافات شائعةً حول السلطة الأبوية المفترض تطبيقها وسلطة الأسرة على أفرادها.
حماية خصوصية العامة
كان الأميركيون يعتمدون على معايير المجتمع والقوانين المحلية فيما مضى لحماية خصوصيتهم، لكن الحكومة عملت على مدار الــ 20 عاماً الماضية، عبر جهودٍ بذلتها الأحزاب السياسية، على أن يكون كلّ فردٍ مسؤولاً عن خصوصيته وسلامته عموماً.
وعلى سبيل المثال، لا توجد إلا القليل من القوانين التي تحدد كيفية قيام الشركات باستغلال بيانات المستخدمين على الإنترنت، ما دامت تُعْلِم المستخدمين بعباراتٍ قانونية غامضة عما ستفعله ببياناتهم، وما دام للمستخدم حرية الاختيار بين الرفض أو القبول، لكنَّ الخيارين الوحيدين المُتاحين للمستخدم هما «قبول» أو «عدم استخدام البرنامج، أو موقع الويب، أو الخدمة».
وهذا الأسلوب القانوني نفسه، لكن بشكلٍ آخر، نراه في إعلانات الأدوية الطبية، وما تقدمه من فائدة، وفي النهاية تطلب منك استشارة الطبيب؛ لتعرف إن كنت في حاجةٍ إلى أخذ الدواء أم لا .
لا أحد لديه الوقت الكافي لقراءة كل بندٍ من بنود إشعار الخصوصية، أو الوقوف بوجه مسوقي البضائع عبر الهاتف، أو أن يقرأ معلوماتٍ غذائية مكتوبة على العلب الغذائية، أو يتحقق من التفاعلات والآثار الجانبية لدواءٍ ما، أو أن يتأكد من أن من يقدم لك الطعام في المطعم ليس مُستبعداً.
لقد استغلت الشركات الثغرة بين أن تكون مسؤولاً بنفسك عن خصوصيتك، وأن تكون الحكومة مستعدةً لتحمل تلك المسؤولية. لقد تجاوزت هذه الشركات مساحات الأميركيين الحميمية، وتسعى لأن تصبح شريكاً لك في فراشك، وستواصل هذه الشركات استغلال بياناتنا الشخصية وانتهاك خصوصيتنا، شئنا أم أبينا، ما لم يتعاون أفراد المجتمع مع الحكومة لفرضِ قيودٍ على هذه العملية التي تنتهك الخصوصية.