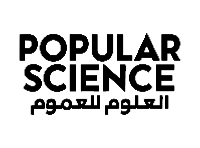في الشهر الماضي، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال بأن فريقاً من الباحثين في الصين كانوا يعالجون المرضى المصابين بسرطان لا علاج له بواسطة تقنية تعديل الجينات المعروفة باسم كريسبر. ووفقاً لتقرير الصحيفة، فإن الباحثين الصينيين يحاولون وقف تطور المرض لدى المرضى المصابين بسرطان المريء عن طريق تعديل جزء من الحمض النووي في بعض خلايا الدم البيضاء. إذ يغير هذا التعديل من الطريقة التي يقوم بها الجهاز المناعي بمكافحة السرطان.
ولكن كيف تفوقت الصين على الولايات المتحدة لتصبح أول من يستخدم تقنية كريسبر عند البشر؟ إذ كان الباحثون الأميركيون هم الذين اكتشفوا قدرة هذه التقنية على تعديل وتغيير الحمض النووي. ولكن كما تشير صحيفة وول ستريت جورنال، فإن أميركا تمشي على خطا الصين. ويُذكر بأن كارل جون - الرائد في العلاج المناعي للسرطان في جامعة بنسلفانيا - ينتظر الترخيص لبدء تجارب مماثلة بنفسه باستخدام تقنيات كريسبر على العلاج المناعي، أي العلاجات القائمة على (تسخير الجهاز المناعي لمكافحة السرطان) لبعض الأورام الخبيثة. وقد يحصل على ترخيص من إدارة الأغذية والأدوية الأميركية قريباً.
ووفقاً لدورية نيتشر، فإن التجارب الأميركية ستكون مماثلة للعلاج المناعي المعتمد حديثاً والذي يدعى كيمرايا. إذ ينطوي العلاج على سحب دم الشخص وعزل الخلايا التائية. وباستخدام شكل آخر من أشكال تعديل الجينات، يقوم فيروس الإيدز المعطّل بوضع أحد المستقبلات على الخلايا التائية (وهي نوع من خلايا الدم البيضاء). ثم تنمو الخلايا التائية المعدّلة وتتكاثر في المختبر. وعندما تصبح جاهزة، يقوم الأطباء بحقن الخلايا التائية المعدّلة حديثاً مرة أخرى في جسم مريض السرطان حيث تعمل على إيجاد الخلايا السرطانية وقتلها. وفي حين أن هذا العلاج يمكن أن يكون فعالاً للغاية (غالباً عند الأشخاص الذين استنفذوا كل الخيارات الطبية الأخرى المتاحة)، فإن العملية بحد ذاتها تستغرق وقتا طويلاً للغاية، وغالباً لا تنجح مع جميع الأشخاص. والهدف من هذه التجربة الجديدة من العلاج المناعي التي تنطوي على تقنية كريسبر هو ثنائي البعد: لمعرفة فيما إذا كان استخدام العلاجات القائمة على تقنية كريسبر هو آمن للبشر فعلاً، وفيما إذا كان من شأن تقنية كريسبر أن تساعد في جعل بعض العلاجات مثل كيمرايا أكثر كفاءة وفعالية.
وفي حال تمت الموافقة، فإن المرحلة الأولى الجديدة من التجربة البشرية سوف تستخدم تقنية كريسبر لتعديل الحمض النووي في الخلايا التائية للشخص بثلاث طرق: الأولى تقوم بنفس آلية فيروس الإيدز في علاج كيمرايا، من خلال وضع مستقبلات يمكنها أن تعثر على السرطان. وتقوم الطريقة الثانية بإزالة البروتين الذي يملك القدرة على العبث بالمستقبلات. ومن شأن التعديل الثالث أن يمنع الخلية السرطانية من العثور على الخلايا التائية عن طريق إزالة البروتين الذي يعمل بمثابة جهاز تتبع - إذا جاز التعبير - للخلية الخبيثة. وإذا نجحت هذه التغييرات، فيمكنها أن تجعل العلاج المناعي أكثر فعالية بكثير. ولأنه من السهل نسبياً استخدام تقنية كريسبر في المختبر، فقد تجعل العلاجات التي تستخدم هذه العملية أكثر كفاءة بكثير، مما قد يزيد من الأمل بالنجاح وينقص الوقت (والمال) الذي يستغرقه صنع الدواء.
ولكن الصين متقدمة بالفعل حتى الآن، وتظهر جهودها في بعض الحالات نتائج إيجابية. فإذا كان الباحثون الأميركيون قد فازوا في اكتشاف كريسبر وفي بداية السباق، فما العائق الذي يسمح للصين بأن تكتسب الصدارة؟ إنه ما يسمى بإدارة الأغذية والأدوية الأميركية، والأمر يستحق خسارة السباق. إذ كان على الباحثين الصينيين عند حصولهم على الموافقة على تجاربهم أن يقدموا خطتهم إلى لجنة الأخلاقيات وآداب مهنة الطب في المستشفى. ووفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن هذه اللجنة تتكون من مجموعة من أطباء المستشفى ومحامٍ ومريض سابق بالسرطان. وقد ناقشت المجموعة هذا الأمر لبضع ساعات قبل الموافقة على التجربة البشرية.
وعلى عكس الصين، فإن الولايات المتحدة لديها نظام أكثر صعوبة بكثير وشديد الدقة لتقديم الدواء أو العلاج الجديد إلى الأسواق. بالنسبة لهذا العلاج على وجه الخصوص، كان على كارل جون تقديم خطته إلى اللجنة الاستشارية للمعاهد الوطنية للصحة (NIH). ثم كان عليه أن يقدم المشروع إلى إدارة الأغذية والأدوية بحد ذاتها، والتي طلبت أن يقوم جون بإجراء المزيد من الفحوصات المخبرية على الخلايا البشرية قبل تجربتها على البشر. وكانت المخاوف الرئيسية الموجودة في بداية تجارب كريسبر الأخرى هي: هل ستقوم أداة تعديل الحمض النووي بإجراء قطع غير مقصود بطريقة مختلفة عن المخطط لها؟ وهل يمكن لهذه التعديلات أن تسبب عواقب سلبية غير متوقعة للمريض، إما على الفور أو في وقت لاحق؟ ولأن تقنية كريسبر هي من الاكتشافات الجديدة، فإن الباحثين في جميع أنحاء العالم قلقون جداً من أن العلماء لم يحيطوا بكافة جوانبها حتى الآن.
ويكون حذر إدارة الأغذية والأدوية في أوجه مع أي شيء يستخدم التعديل الجيني أو تقنية كريسبر. ولكن الأدوية الأخرى تمر بعملية صارمة للغاية أيضاً. وهذا كله لسبب وجيه: فقبل وجود إدارة الأغذية والأدوية، كان بإمكان المصنعين تسويق وبيع أي دواء دون الحاجة إلى الإفصاح عن مكوناته ودون الحاجة إلى إظهار إمكانية علاجه فعلاً للمرض الذي قمت بشراء الدواء لعلاجه. وفي حين أنه من الصعب تقبل فكرة احتمال خسارة السباق في أحد الاكتشافات الطبية، فمن المهم أن نتذكر كيف ولماذا أنشأت الولايات المتحدة إدارة الأغذية والأدوية في المقام الأول.
نحن نأخذ اليوم أدوية بناءً على وصفة طبية ونحن نعرف بالضبط ما هي الآثار الجانبية التي يمكن أن تحدث وما هو الاحتمال العام لحدوثها. ولكن تخيل تناول دواء جديد دون معرفة هذه المعلومات الأساسية. هل ما زلت تريد تناولها؟ نحن لا نفكر غالباً في العملية الشاقة والطويلة التي تمر بها الأدوية الآن قبل أن تصل إلى أجسادنا. ولكن هذه العمليات موجودة لسبب وجيه جداً. فكّر في العلاج بزرع البراز، والذي يتضمن جمع البراز من المتطوع وإعطاءه إلى شخص مصاب بإنتان الأمعاء الشديد الناجم عن البكتيريا التي تسمى المطثية العسيرة، حيث أنه يظهر نجاحاً هائلاً، ولكن لم يتم الموافقة عليه حتى الآن من قبل إدارة الأغذية والأدوية.
يعود جزء من السبب إلى أن بعض العلاجات مثل دراسات تقنية كريسبر هي بمثابة استكشاف المجهول. إذ لا يزال الكثير من العلماء لا يفهمون البكتيريا المتعايشة في أمعاء الإنسان (أي مجموعة البكتيريا التي تعيش في الأمعاء) وآثارها على صحتنا. ويمكن بالفعل لزرع البكتيريا المتعايشة في أمعاء أحد الأشخاص عند شخص آخر أن تشفيه من الإنتان، ولكن يمكنها أن تسبب أيضاً عواقب غير مرغوب فيها. إذ أن للبكتيريا المتعايشة تأثير على كل من الهضم والجهاز المناعي. من الناحية النظرية، قد يكون الشخص المتلقي لزرع البراز عرضة لخطر أكبر للإصابة باضطرابات الجهاز المناعي بسبب البكتيريا المتعايشة التي توجد في أمعائه الآن. وفي الوقت نفسه، وكما هو حال مرضى السرطان في تجارب العلاج المناعي بتقنية كريسبر، فإن المرضى المصابين بالتهاب القولون بالمطثية العسيرة غالباً ما يكونون بحالة مهددة للحياة ويكون زرع البراز هو المحاولة الأخيرة للقضاء على الإنتان. ويعترف الباحثون بأنه من الصعب أن نعرف على وجه اليقين مدى الحذر الذي يجب توخيه عندما يكون هؤلاء الناس الذين يمكن أن يستفيدوا من هذا العلاج بحالة مهددة للحياة. ويكون معظم المرضى في دراسات العلاج المناعي قد استنفدوا جميع العلاجات المتاحة الأخرى.
كي يصل الدواء إلى خزانة الأدوية لديك، فإنه يحتاج لأن يمر بثلاث مراحل من التجارب السريرية. المرحلة الأولى هي ببساطة لإظهار أن الدواء أو العلاج ليس ساماً. إذا استطاع الدواء تجاوز هذه المرحلة، فإنه ينتقل إلى المرحلة الثانية التي يجب أن يؤكد فيها مرة أخرى بأنه غير سام، ولكن أن يثبت فعاليته أيضاً، وبأنه يقوم بالمهمة التي من المفترض أن يقوم بها. وفي المرحلة الثالثة، يجب على الباحثين اختبار الدواء في مقابل العلاج المتاح حالياً للمرض (إذا كان هناك علاج) الذي يحاول الدواء الجديد علاجه. إذا لم يكن الدواء أفضل من الدواء الموجود حالياً في الأسواق ولم يكن هناك أي صفات أخرى مفيدة مثل كونه أرخص، أو آثاره الجانبية أقل شدة، عندها يكون من الصعب جداً على شركات الأدوية أن تحصل على موافقة إدارة الأغذية والأدوية للبدء بتسويق الدواء.
وتعدّ كل خطوة من هذه العملية طويلة وشاقة ولكن هذه العقبات موجودة لسببين رئيسيين ومهمين: لتحديد مدى سميّة الدواء (وبعبارة أخرى، ما هو احتمال تسببه في مقتلك أو التسبب بأشكال أخرى من الضرر الجسدي قصير وطويل الأمد؟)، وهل يقوم فعلاً بما هو مفترض أن يقوم به؟ فإذا كان من المفترض لأحد الأدوية أن يقلل من أعراض حرقة المعدة، فهل يقوم بذلك في الواقع؟ ويبدو هذا كله واضحاً كي يتواجد مثل هذا النوع من الاختبارات. ولكن السبب الوحيد لوجودها هو أنه كان هناك وقت لم تكن موجودة فيه.
بالعودة إلى عام 1906، أصدر كونجرس الولايات المتحدة النسخة الأصلية من قانون الغذاء والدواء (السابق لإدارة الأغذية والأدوية اليوم). وكان الهدف الرئيسي للقانون في تلك المرحلة هو منع تعرّض شراء وبيع المواد الغذائية والمشروبات والأدوية لأي شكل من أشكال سوء التصنيف أو التلوث. ببساطة، كان على المنتج أن يحتوي على المحتويات المذكورة على الملصق التعريفي.
وتعدّ القوانين الحالية التي تحكم عملية الاختبار في إدارة الأغذية والأدوية هي نتاج أخطائنا الخاصة. ففي عام 1937، بمجرد أن وصل دواء يسمى إليكسير سلفانيلاميد إلى الأسواق، فسرعان ما تسبب بوفاة 107 أشخاص، وكان كثير منهم من الأطفال. وكان عنصر سلفانيلاميد الفعال في الدواء يستخدم في ذلك الوقت كنوع من المضادات الحيوية المستخدمة لعلاج كل شيء من مرض السيلان إلى التهاب الحلق العقدي. وكان الدواء يأتي أصلاً على شكل حبوب. ولكن قررت إحدى الشركات الدوائية – شركة إس إي ماسنجيل - بأن العلاج سيكون أكثر شعبية إذا كان على شكل شراب منكّه. ولذلك جعلت أحد الصيادلة يقوم بمزج سلفانيلاميد مع ديثيلين جلايكول والماء، بالإضافة إلى القليل من نكهة التوت. وبمجرد الانتهاء منه، قامت بتسميته وفقاً لذلك، ووزعت عبوات منه في جميع أنحاء البلاد، وقامت الصيدليات بشرائه بسهولة.
ويعدّ ديثيلين جلايكول قابلاً للامتزاج بشدة، لدرجة أنه رائع في خلط أي جسيمات في السائل جيد التشكيل. وعلى هذا النحو، لاقت التركيبة الجديدة نجاحاً كبيراً، حتى بدأ الناس بأخذها في الواقع. إذ تبين أنه بالإضافة إلى قابليته العالية للامتزاج، فإن ديثيلين جلايكول هو أيضاً سام جداً للإنسان، ويسبب الفشل الكلوي الحاد الفوري. وسرعان ما بدأت تقارير الوفيات تأتي من الأشخاص الذين تناولوا الدواء السائل. وتم سحبه من الأسواق بسرعة. في ذلك الوقت، انتقل الدواء فوراً من المختبر إلى خزانة الدواء، دون إجراء أي اختبارات مسبقة. وهكذا، في العام التالي - أي في عام 1938 - أصدرت الولايات المتحدة القانون الاتحادي للغذاء والدواء ومستحضرات التجميل، والذي يتطلب أن تثبت الأدوية الجديدة بأنها آمنة قبل أن يتم البدء ببيعها، وهو ما يتوافق في الأساس مع المرحلة الأولى من عملية الموافقة على التجربة السريرية في الوقت الراهن. وبدأ ذلك موجة جديدة تماماً من القوانين، والتي كانت تقربنا كل سنة خطوة واحدة من العملية الشاقة جداً الموجودة اليوم. وللأسف، لم يكن السلفانيلاميد هو الحادث الوحيد المشؤوم الذي أدى إلى هذه العملية التنظيمية. فقد ساهمت بعض المآسي الأخرى في القرن الماضي أيضاً.
وفي الحالة سيئة السمعة للثاليدوميد في الستينيات، فقد كان دواء (ثاليدوميد) عبارة عن حبوب للنوم والتي سرعان ما أصبحت شائعة على نطاق واسع في ألمانيا. وبعد وقت قصير، اكتشف الأطباء الأستراليون بأنه يمكنه أيضاً أن يخفف الغثيان الصباحي أثناء الحمل. ولذلك بدأ الأطباء بوصف الدواء بشكل مغاير لاستطبابه (وهي عادة لا تزال تستخدم بكثرة اليوم) للنساء الحوامل. ولكن في حين أجري مسبقاً بعض الاختبارات لتحديد مدى أمان أخذ الدواء من قبل البشر، إلا أن أحداً لم يقم بدراسة آثار الدواء على الجنين الآخذ بالنمو. وسرعان ما وجد العالم بأنه يمكن أن يسبب تشوهات خلقية شديدة، مما تسبب بشكل خاص في قصور الأطراف أو غيابها بالكامل. وقد قاد ذلك في جزء منه الولايات المتحدة إلى إنشاء قوانين أكثر صرامة بشأن صرف الأدوية، مما يتطلب من صانعي الأدوية إثبات فعالية أدويتهم قبل أن تتمكن من الحصول على موافقة إدارة الأغذية والأدوية.
علينا أن نشكر أدوية تحديد النسل على القوانين التي تلزم أن تأتي هذه الأدوية مع حزمة من المعلومات للمريض والتي يذكر فيها كل الآثار الجانبية الممكنة واحتمال حدوث كل واحد منها. في البداية أوشكت أدوية تحديد النسل على أن يتم سحبها من الأسواق تقريباً بسبب آثارها الجانبية الخطيرة. ولكن من وجهة نظر قانونية، فقد دفعت النساء نحو رغبتهن بامتلاك الخيار أولاً، في حال كنّ يوافقن على تناول الدواء مع خطر حدوث أي آثار جانبية. واليوم، عادة ما يتم تقديم الأدوية بهذه الطريقة من قبل الأطباء لمرضاهم، من خلال المقارنة بين الفوائد والمخاطر، التي يتم توفيرها بوضوح ودقة، مع السماح للمريض بالاختيار.
إذاً فقد تعلمنا من الماضي بأنه من الحكمة أن نبقى حذرين ونخضع للإجراءات التنظيمية التي تم تطويرها على مدى قرن من الزمن.