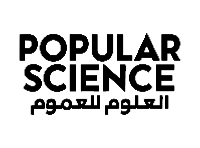هل يمكن لمشاركة التجارب الشخصية أن تساعدنا على تحسين صحتنا النفسية وتخطي الأزمات؟
كتب الروائي والناقد الألماني «والتر بنيامين»، إبان الحرب العالمية الأولى: «عندما انتهت الحرب، عاد الرجال من ساحة المعركة، ولكنهم كانوا أكثر صمتاً. لم يكن لديهم الكثير ليقولوه، بل كانوا أقلّ قدرةً على التواصل مع محيطهم»، وكذلك الطلّاب، قد تنعكس عليهم أزمة جائحة كورونا وتؤثّر على تجاربهم سلباً. في كل يوم تقريباً، كانوا يسمعون سيلاً من الأخبار المقلقة من جميع أنحاء العالم. مع ذلك، سيفتقر الكثيرون منهم إلى ذكريات وقصص واحتفالات المدرسة والجامعة التي تثري تجربتهم ومخيلتهم؛ والتي يمكنهم إعادة سردها لأقرانهم وأحبائهم في السنوات اللاحقة، لن يكون لديهم سوى ذكرياتٍ أخرى عن إلغاء الدروس والامتحانات، الفقد، والقصص الحزينة.
إذا استمعت لحديث أية مجموعةٍ من الطلاب، ستجد أن قصصهم متشابهة. سيتحدثون غالباً عن كيف تم إلغاء رسوم تسجيل أو تعديلها في المدارس والجامعات، وكيف باتوا يتعلّمون عن بعد، وعن تكيّفهم مع قواعد التباعد الاجتماعي، أو حتى كيف لم تتح لهم الفرصة بالاحتفال بعيد ميلاد كلّ منهم، وبالتأكيد؛ سيتأثرون بتجارب بعضهم.
في الواقع، تُعتبر رواية القصص والتجارب الشخصية، وسائل تكيّف مهمةً للغاية؛ تمكّن الأفراد من عرض رؤيتهم في الأحداث الكبرى، وإثراء فهمهم حول التجربة الإنسانية.
وفي هذا الصدد؛ فإننا نوصي بسرد القصص باستخدام أشكال الفنون الشفوية والكتابية والإبداعية، وربط الأحداث الرئيسية لتشكيل حبكةٍ، وبالتكيف والارتجال، ومشاركة القصص لاكتشاف كيف يمكن لأشخاصٍ مختلفين جداً مشاركة نفس تجارب الحياة، وكيف يمكن للطبيعة البشرية التكيف مع هذه الأوقات الصعبة وتجاوزها.
قصصٌ مفقودة
فقدان الأحداث المهمة؛ سواء أكانت تقليديةً؛ مثل احتفالات التخرّج من المدرسة، أو نشاطاتٍ يومية روتينية؛ مثل ممارسة الرياضية اليومية أو غيرها من الأنشطة الأخرى، يمكن أن يكون لها تأثيرات عميقة وطويلة الأمد على الطلاب.
تُعتبر طقوس الانتقال من مرحلةٍ لأخرى -مثل حفلات التخرّج الرسمية- مناسباتٍ ثقافيةً مهمة؛ تقوّي العلاقات بينهم، وترسّخ أسس الرفاه الدائم. إنها نفس القصص التي نرويها مراراً وتكراراً خلال حياتنا؛ والتي تحدد انتماءَنا للآخرين، ولن يكون فقدها مجرّد خسارة بسيطة للحظاتٍ وذكريات عفوية.
في الواقع، تترسّخ في هذه المرحلة الحساسة من تطور دماغ المراهق، أسس تجاربه الخاصّة للعقود القادمة.

تعتبر سنوات المراهقة؛ المعروفة بالفترة الحسّاسة الثانية من تطور الدماغ، مهمةً لأن الدماغ يبدأ فيها بالتشكّل النهائي، ويكتسب خلالها المهارات الأساسية؛ متأثراً بالتجارب البيئية الفريدة لكلّ فرد فينا.
تؤدي عملية التقليم المشبكي هذه؛ التي تبدأ مع بداية سن البلوغ وتستمر لمدة 5 سنوات على الأقل، إلى إزالة الخلايا والوصلات العصبية غير المستخدمة في الدماغ، بينما يتم تعزيز الاتصالات المستخدمة بين العصبونات، وتقويتها لترتبط ببعضها عبر موصلاتٍ مشبكيةٍ متينة؛ تُغطى بمادةٍ تُدعى «الميالين».
تتحسّن وظيفة الذاكرة والمعالجة، لكن الدماغ في هذه المرحلة يكون أكثر عُرضةً وحساسيةً للأمراض العقلية بسبب عملية تشكّل الدماغ المكثفة. في الواقع، هناك مخاوف متزايدة من أثر ظروف الجائحة الحالية على تطوّر عقول الجيل الجديد، لأن عقولهم تعرّضت لتجارب قاسية؛ مثل خيبات الأمل، وروتين الحياة المضطرب، وتفويت الأحداث المهمة، القلق المستمر، الخوف والتوتر مما تحمله الأيام والأشهر ،وحتى السنوات القادمة.
يشير علم الأعصاب إلى أن التعرّض لمثل هذه التجارب القاسية في سنّ المراهقة ربّما يؤدي لانخفاض الأداء الذي قد يستمر مدى الحياة، وقد ينطوي على تدهور الصحّة وانخفاض التحصيل العلمي، وفقدان التفاؤل والأمل.
كل شيء مختلف
تُقدّر منظمة اليونسيف؛ التابعة للأمم المتحدة، أن 1.6 مليار طالب، و91% من المدارس في عام 2020، قد عانوا من ظروف التعليم في الحالات الطارئة؛ أي كان هناك تحوّل عن الروتين المعتاد في التدريس والتعلم والحضور والمناهج؛ كاستجابةٍ لظروف جائحة فيروس كورونا.
لقد كثر الحديث عن ضرورة مساعدة المراهقين من قبل ، والصدمات.
إذاً كيف يمكننا ضمان أن يكون شبابنا سعداء ولا يعانون من أية مشاكل وفقاً لمؤشرات الرفاه؛ مثل طموحات الشخص وإدراكه لصفات حياته ونوعيتها؟ في الحقيقة، يُعتبر تحقيق التوقعات وتجاوزها قليلاً مفتاح السعادة والرفاهية. عندما يكون المرء سعيداً؛ فإن هناك توافقاً أو زيادة طفيفة بين ما هو مثالي أو مُتوقع مع الواقع.

وفي عامٍ مليء بخيبات الأمل والتوقعات التي لم تتحقق، لم يكن هناك مهرب من حدوث تأثيراتٍ سلبية على الرفاهية والسعادة الذاتية. يمكننا أن نستشفّ ذلك من خلال زيادة أعداد الباحثين عن الدعم النفسي بشكلٍ كبير عام 2020.
هناك مخاوف محزنة تم تحديدها عالمياً، ومن قِبل مركز الشباب الأسترالي؛ تتركز حول أن كل جانب من جوانب كيفية عيش الشباب وتعلمهم وعملهم، قد تغير إلى الأبد بسبب جائحة فيروس كورونا، وستظل آثارها على جيل الشباب اليوم خلال العقد القادم.
أهمية مشاركة تجارب عام 2020
يمكن للشباب الاستفادة من فرصة إنشاء القصص وتذكرها، وإعادة سردها؛ كوسيلةٍ للتصالح مع تجاربهم مع الوباء، بهدف مساعدتهم في التعافي، وخلق التفاؤل بالمستقبل من أجلهم ومن أجل مجتمعاتهم.
رواية القصص تتطلب أن يكون هناك مستمع لها؛ بالتالي يظهر مجتمع مبني على التجارب المشتركة، يقوم على التفاهم وقبول الآخر؛ وذلك ضروري لتعزيز الشعور بالانتماء والرفاهية، وفي هذا الصدد؛ يشير تسارع التغيير واحتمال الانتقال إلى «نمط حياةٍ جديد»، إلى الحاجة لسرد قصصٍ تشرح لماذا وكيف حدث هذا التغيير؟ وكيف عانى كلّ فرد فينا من هذا التغيير؟ لقد أظهرت الأبحاث الصحية أنه قد تكون هناك فوائد علاجية لسرد القصص؛ حيث يُشجَّع الأشخاص الذين يروون القصص كطريقةٍ للتكيّف مع مواضيع مثل الصدمة والقلق والمرض، على تناولها من خلال تجاربهم، وتعميق إدراكهم لما هو مهم في حياتهم.
لذلك بات المهنيون الصحيون مهتمين أكثر بطريقة رواية القصص بشكلٍ جماعي، والآن، هناك حاجة إلى رواية القصص والتجارب في المدارس والجامعات أكثر من السابق؛ حيث تتقاطع حياة المعلمين مع حياة الطلاب باستمرار، ولديهم القدرة على إحداث تأثيرٍ كبير.

يمكن مشاركة التجارب وخيبات الأمل من خلال تطوير مهارات سرد القصص؛ مثل تعلّم كيفية احترام وجهات النظر المتعددة، وتفهّم أن للمستعمين والرواة آراءٌ مختلفة إزاء الأحداث، ويمكن أن يوفّر لنا ذلك طريقةً لتأريخ الأحداث ومشاركتها، وإضفاء معنىً على تجاربنا؛ بالتالي تمكين إعادة صياغة الأحداث وسردها؛ حتى لو كانت تعكس خيبات الأمل والتوقعات.
وللمعلمين دورٌ محوري في هذه العملية من نواحٍ عديدة، ليس في إعداد الجوّ المناسب لرواية القصص وحسب، ولكن في التركيز على سرد قصص النجاح؛ سواء الشخصية أو القصص التي يعرفونها عن الآخرين، ليفتحوا بذلك نوافذ جديدةً من الفرص للتفكير والعمل في المستقبل؛ وبذلك نحفّز الاتصال مجدداً بالعمليات الهامّة في وعي المراهقين، لإحداث تغييرات دائمة ومفيدة على الأداء العصبي أو النفسي لهم؛ مما يمنحهم منظوراً أكثر تفاؤلاً، ومفعماً بالأمل، بدلاً من منظور خيبة الأمل والفقد والندم.
ستتزايد أهمية سرد القصص بالنسبة لجميع الطلاب، بينما نمضي قدماً في ظل ظروف عدم اليقين عام 2021.
هذا المقال محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يُعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً