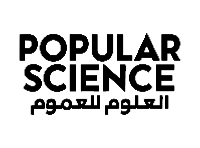تُظهر عناوين الأخبار في الأشهر الأخيرة قصة رعب بيئية عالمية.
يقيس الباحثون في مرصد ماونا لوا -الذي يقع فوق أحد البراكين في هاواي- مستوياتٍ غير عادية من ثلاثي كلورو فلورو الميثان في الغلاف الجوي، وتُثير هذه القياسات حَيرة المجتمع العلمي، فقد تم رصد غاز ثلاثي كلورو فلورو الميثان -وهو مستنفِد قوي للأوزون- بعناية منذ أن تم حظره بموجب بروتوكول مونتريال لعام 1987، ولكن سرعان ما تم تأكيد القياسات في محطات الرصد في جرينلاند وساموا الأميركية والقارة القطبية الجنوبية، وتشير الأدلة إلى الإنتاج غير المشروع لهذه المادة الكيميائية المحظورة، مما يهدد الانتعاش الهش لطبقة الأوزون التي تقي من الأشعة فوق البنفسجية، لكنَّ هوية المتسبب في هذه المشكلة البيئية لا تزال لغزاً.
إذن قد حدث اختراق! ومن خلال عكس اتجاه النماذج المناخية العالمية، يقوم فريق من العلماء في بولدر، كولورادو، بتتبع مصدر ثلاثي كلورو فلورو الميثان إلى شرق آسيا، ويتم التقاط هذا المسار من قبل وكالة التحقيقات البيئية، وهي منظمة صغيرة ناشطة مقرها فوق مقهى في إزلينغتون بلندن، حيث ترسل هذه الوكالة المحققين إلى الصين لتكشف عن إنتاج غير مشروع لثلاثي كلورو فلورو الميثان، من أجل إنتاج رغوة العزل المستخدمة في صناعة الإنشاءات في الصين. تقول كلير بيري (رئيسة حملة المناخ في وكالة التحقيقات البيئية): "هذه جريمة بيئية واسعة النطاق".
يلتقي في هذه الأثناء علماء ودبلوماسيون من جميع أنحاء العالم في فيينا لحضور اجتماع فريق العمل التابع للأمم المتحدة، والمعنيِّ ببروتوكول مونتريال، وقد تم وضع التقرير الرائد لوكالة التحقيقات البيئية على رأس جدول الأعمال. ولكن هل يمكن للمجتمع الدولي أن يجتمع مرة أخرى لحماية طبقة الأوزون والحفاظ على "أكثر معاهدات البيئة نجاحاً في العالم"؟
نموذج للتعاون
في المرة الأخيرة التي كان فيها ثقبُ الأوزون خبراً في الصفحة الأولى، كان الرئيس رونالد ريجان لا يزال يأكل الحلوى في المكتب البيضاوي، وفي عام 1985 أعلن علماء بريطانيون عن اكتشاف انخفاض هائل في تركيزات الأوزون في الغلاف الجوي فوق القارة القطبية الجنوبية. كان "ثقب الأوزون" -كما أصبح معروفاً بعد ذلك- ناتجاً عن المواد الكيميائية التي تتغذى على الأوزون، والمعروفة باسم مركبات الكربون الكلورية الفلورية المستخدمة كمواد مبردة في مكيفات الهواء، ومواد دافعة في علب الرذاذ المضغوط.
أثار هذا الاكتشاف الرأي العام، لا سيما بسبب الخوف من خطر الإصابة بسرطان الجلد، وإعتام عدسة العين، وحروق الشمس المرتبطة بزيادة التعرض للأشعة فوق البنفسجية. وقد كانت الحملات الإعلانية الشهيرة في أستراليا ونيوزيلندا -والتي تتضمن نورساً راقصاً- تشجع روادَ الشاطئ على "ارتداء قميص سهل النزع، ودهان القليل من الواقي الشمسي، وارتداء قبعة"!
وعلى الرغم من أن الكثير من الشكوك العلمية كانت ما تزال قائمة -والتي تم استغلالها بحماس من قبل الشركات الكيميائية- إلا أن الرئيس ريجان قد أدرك الخطر الذي يُشكله ثقب الأوزون، ودعم بقوة المفاوضات الدولية لحظر مركبات الكربون الكلورية الفلورية، بما في ذلك ثلاثي كلورو فلورو الميثان، وفي الأول من يناير 1989، أصبح بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفِدة لطبقة الأوزون قانوناً.
وقد أعلن ريجان في بيان التوقيع أن بروتوكول مونتريال "نموذج للتعاون" و"نِتاج الاعتراف والإجماع الدولي بأن استنفاد الأوزون هو مشكلة عالمية". ويظل هذا البروتوكول هو إنجازه البيئي الأبرز.
تأثير دائم على مناخ الأرض
لقد بدأت تظهر بعض علامات تعافي طبقة الأوزون بعد ثلاثة عقود على بروتوكول مونتريال؛ ففي يناير من عام 2018، أجرت وكالة الفضاء الأميركية ناسا دراسة ووجدت فيها أن ثقب الأوزون كان في أصغر حجمٍ له منذ عام 1988، وهو العام الذي سبق عام دخول بروتوكول مونتريال حيز التنفيذ. لكن التعافي الكامل سيستغرق عدة عقود، حيث تقول العالمة آن دوغلاس من وكالة ناسا، والتي شاركت في تأليف الدراسة: "إن عمر مُركبات الكربون الكلورية الفلورية من 50 إلى 100 سنة، لذلك فهي تظل في الغلاف الجوي لفترة طويلة جداً، وإننا نتطلع إلى عام 2060 أو 2080 لزوال ثقب الأوزون".
وفي غضون ذلك تستمر مركبات الكربون الكلورية الفلورية في التأثير على مناخ الأرض بطرق غير متوقعة، فهي غازات دفيئة قوية، تَزيد قدرتها أكثر من 5000 مرة عن قدرة الاحترار للمعادل الوزني لثاني أكسيد الكربون، وتشير التقديرات إلى أن حظر مُركبات الكربون الكلورية الفلورية والمواد الكيميائية الأخرى المستنفِدة للأوزون قد أخَّرت الاحترار العالمي بمقدار عقدٍ من الزمن.
ومع ذلك، فإن هذه المكاسب تُهدِّدها المواد الكيميائية الصديقة للأوزون، ولكنها مواد تحتجز الحرارة، وهي التي حلت محل مركبات الكربون الكلورية الفلورية في مكيفات الهواء ومواد العزل، وسيعمل التعديل الأخير في بروتوكول مونتريال على التخلص التدريجي من استخدام هذه الفئة الجديدة من المواد الكيميائية بحلول عام 2028.
والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو التأثير المعقَّد لثقب الأوزون على الغلاف الجوي للأرض والمحيطات؛ فقد أدى فقدان الأوزون الممتص للأشعة فوق البنفسجية فوق القطب الجنوبي إلى تغيير نمط الرياح حول القارة القطبية الجنوبية، حيث تجذب الرياح العاتية التي تهب فوق المحيط الجنوبي المزيدَ من المياه العميقة نحو السطح، حيث تتم "تهويتها" عن طريق ملامستها للغلاف الجوي.
والمياه العميقة في القطب الجنوبي غنية بالكربون، مما يضعف امتصاصها لثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي، وهذا يعني أن كفاءة المحيط في إزالة ثاني أكسيد الكربون الزائد في الغلاف الجوي صارت أقل، مما يقلل من قدرته على موازنة الاحترار العالمي.
الدروس المستفادة من تجنب هذه المواد
يعطي نجاح بروتوكول مونتريال دروساً في الجهود الرامية الآن إلى مواجهة التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية، وقد كانت القيادة القوية للرئيس الأميركي ريجان ورئيسة الوزراء البريطانية آنذاك مارجريت تاتشر، وهي كيميائية مدرَّبة، وحاسمة خلال المفاوضات حول المعاهدة. وقد بدأ البروتوكول متواضعاً، وتم تصميمه ليكون مرناً؛ بحيث يمكن التخلص التدريجي من المواد المستنفِدة للأوزون بواسطة تعديلات لاحقة، كما تم تزويد البلدان النامية بالحوافز والدعم المؤسسي من أجل تحقيق التزامها بالأهداف الخاصة بها.
ولكن ربما يكون الدرس الأهم هو الحاجة إلى العمل، حتى عندما يكون العلم ما يزال غير حاسم؛ يقول شون ديفيز (عالِم المناخ في الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي): "لا نحتاج إلى اليقين المطلق لنتحرك، فعندما تم التوقيع على بروتوكول مونتريال، كنا أقل ثقة بمخاطر مركبات الكربون الكلورية الفلورية من ثقتنا اليوم بمخاطر انبعاثات الغازات الدفيئة".