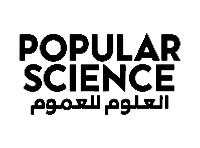في أعماق "منزل الخوف" (أكثر الوجهات السياحية رعباً في بيتسبيرج) تكمن مخلوقات الزومبي والشياطين جنباً إلى جنب مع عالمة اجتماع مهووسة بالخوف. بدأت مارجي كير تدرس الخوف منذ أكثر من عقد، وهي تحاول في تجربتها الأحدث أن تعرف ما الذي يدفع الناس لوضع أنفسهم -طوعاً- تحت رحمة وحوش تحمل السواطير في هذا الوقت من السنة.
وتعمل كير عالمة اجتماع مقيمة في منزل الخوف، وتستخدم نتائجها أيضاً في المساعدة على تعديل التصاميم في المنزل لزيادة الرعب إلى أقصى درجة.
ولكن عمل كير يتجاوز مجرد زيادة تأثير اللحظات المرعبة، ففي حين أن الخوف يُعتبر إجمالاً من العواطف السلبية -على الرغم من أننا لا ننكر مساعدته في استمرار النوع البشري- إلا أن أحدث أبحاثها يشير إلى أن الخوف قد يكون ذا أثر عجيب على المزاج، كما أنه قد يساعد -في تناقض غريب- على الاسترخاء. أي أن الأشخاص الذين يخوضون تجربة مرعبة طوعاً يخرجون منها أكثر سعادة وأقل توتراً، وفقاً للنتائج التي توصلت إليها بالتعاون مع زملاء من جامعة بيتسبيرج. وقد تبين لها أن مستويات النشاط الدماغية لدى هؤلاء الأشخاص قد تناقصت بشكل يشبه ما يحدث عند التأمل أو الجري لمسافة خمسة كيلومترات.
وقد جهز الباحثون مختبراً مرتجلاً في قبو المنزل المسكون، واستعانوا بأشخاص ممَّن اشتروا بطاقات الدخول إلى المنزل من قبل، وذلك لضمان أن الجميع سيشاركون طوعاً. غير أن قبواً مرعباً يختلف بعض الشيء عن المختبرات العادية. تقول كير: "لقد كان تنسيق العمليات والأمور اللوجستية أمراً صعباً، ولكن في غاية الإثارة، ولم نشعر بالملل للحظة واحدة. إنه أيضاً برهان جيد على إمكانية جمع البيانات النفسية في بيئات العالم الحقيقي".
وعلى مدى عامين، اشترك أكثر من 250 شخصاً في التجارب، وذلك بالإجابة عن استبيانات حول المزاج قبل الدخول في المنزل المرعب وبعده، كما خضع أكثر من 100 منهم إلى قياس النشاط الدماغي باستخدام التخطيط الكهربائي للدماغ.
وبشكل عام، كان المشاركون يخرجون من البيت المسكون وهم يشعرون بسعادة أكبر، وقلق وتعب وتوتر أقل. كما أن النشاط الكهربائي في أدمغتهم -وهو الذي يعبر عن شدة عملها- كان ينخفض أيضاً. وقد ظهر الأثران بشكل واضح عند من دخلوا وهم يشعرون بالملل أو التعب، ومن وجدوا التجربة غاية في الإخافة أو الإثارة.
وكما في حالة التأمل، فإن نوبات الخوف الشديد يمكن أن تتركنا في حالة من الهدوء الكامل بإطفاء أقسام الدماغ التي تمنعنا عادة من التركيز على الحاضر، حيث تقول كير: "في هذه اللحظات شديدة الإخافة نصبح أكثر ارتباطاً بأجسادنا، بحيث نتوقف عن تحديد الأولويات ورسم الإستراتيجيات بعيدة المدى، ونركز فقط على اللحظة الحاضرة"، ويتحول هذا إلى شعور جيد، ويفسر تناقص النشاط الدماغي.
غير أن الخوف ليس متساوياً في جميع الحالات، وقد يكون الدخول طوعاً في التجربة مقدمة ضرورية للشعور الجيد بعدها، حيث إن التعرض للسطو ضمن زقاق مظلم مثلاً لا يؤثر إيجاباً على الشخص، كما يقول العلم. إذن فإن وجود إحساس بالسيطرة أمر هام لجني ثمار هذه الحفلة المرعبة، وذلك وفقاً لديفيد زالد (عالم أعصاب في جامعة فاندربلت وغير مشارك في هذا البحث الجديد)، حيث يقول: "إذا كنت تقرأ إحدى روايات ستيفن كينج المرعبة، وشعرت بأن الخوف زاد عن حده، يمكنك ببساطة أن تغلق الكتاب". إن إدراك وجود مهرب يسمح لعقلك الواعي بالتغلب على الرغبة في الهروب الفوري من الوضع.
وهذا لا يعني طبعاً أنه يجب أن نشاهد دفعة كبيرة من أفلام الزومبي بدلاً من الاسترخاء في الحمام مع فقاعات اللافندر عند الشعور بالتوتر؛ حيث إن الخوف بهذه الطريقة ليس مما يفضله الكثيرون، وهناك على الأرجح سبب جيد لهذا.
وقد كان زالد يدرس التفاعلات الكيميائية في الدماغ التي تُحدث استجابة للنشاطات الجديدة والمثيرة، ويعتقد أن البعض منا قد يحصل على جرعة أعلى من الدوبامين (الهرمون المرتبط بالمتعة) في المواقف المخيفة، وهو ما يمكن أن يفسر أيضاً السبب الذي يدفع بالبعض إلى محاولة تناول أكثر أنواع الفليفلة حدة في العالم من أجل "الإثارة المؤلمة"، في حين يتجنب الآخرون أي أثر للطعم الحار في الطعام. ولكن في جميع الحالات، فإن التجديد عامل هام، ولهذا يجب على الأرجح ألا تعود إلى نفس المنزل المسكون أو تشاهد نفس الفيلم المرعب مرتين، حيث إنها لن تقدم لك نفس الدفعة من الإثارة كما في المرة الأولى.
وتحاول كير أيضاً أن تدرس الاختلافات التي تميز محبي الإثارة ومدمني البيوت المسكونة عن غيرهم، وتقول إنها ستجمع البيانات للإجابة عن هذا السؤال في وقت لاحق. ولهذا، إذا فكرت يوماً أن تزور أحد منازل الرعب في عيد الهالوين، فلا تشعر بالصدمة إذا رأيت عالمة مجنونة محبة للرعب تحاول استدراجك إلى القبو لدراسة دماغك.