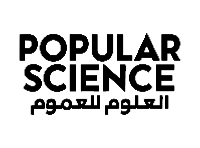خلف كل اكتشاف يحوز على جائزة نوبل، توجد عملية طويلة وشاقة وجماعية تتطلب الكثير من السنوات والعقول، غير أن الباحثين لا يقفون على أكتاف العمالقة فقط، كما قال إسحق نيوتن فيما مضى، بل يستخدمون أيضاً أجهزة رائعة لمساعدتهم على الرؤية بشكل أفضل وقياس النتائج بشكل أدق أو معالجة البيانات بشكل ممتاز. وهذه هي الأدوات التي مكَّنت الفائزين بجائزة نوبل في 2018 من الحصول على الذهب:
قال تشارلي وود من بوبساي إن جائزة هذه السنة في الفيزياء كانت: "تفضيلاً نادراً للتكنولوجيا على الفيزياء الأساسية"؛ حيث إن الفائزين الثلاثة -بما فيهم أول امرأة تفوز بالجائزة منذ 55 سنة- هم من المحترفين في مجال التلاعب بالضوء.
فقد اكتشف آرثر أشكين وسيلة لإيقاف الأجسام وإمساكها ضمن شعاع ضوئي (وهي مماثلة -كما يلاحظ وود- لشعاع السحب في أفلام الخيال العلمي Star Trek)، غير أن "الملقط الضوئي" الحقيقي الذي ابتكره أشكين يقوم بشكل أساسي باحتجاز الجسيمات الصغيرة أو البكتيريا، وعندما يتحرك الليزر تتحرك معه الأجسام التي يحتجزها. وتأمل ناسا أن تستخدم هذه التكنولوجيا لالتقاط وتحليل الغبار الفضائي أو البلورات الجليدية الكونية.
أما جيرار مورو ودونا ستريكلاند، فقد أوجدا طريقة لتضخيم الليزر دون تدمير الجهاز الذي يولِّده، وذلك عن طريق مطِّ الليزر باستخدام كابل من الألياف الضوئية، ومن ثم إعادة ضغطه ثانية بحيث نحصل على نبضة مركزة وقصيرة، ونشر الباحثان النتائج في 1985، وقد استخدمت هذه التقنية -المسماة بتضخيم النبضة المزقزقة- في الكثير من التقنيات منذ ذلك الحين، بدءًا بقَطْع المعادن ووصولاً إلى جراحة تصحيح البصر.
ومن الجدير بالذكر أن كل هذا كان مستحيلاً منذ حوالي نصف قرن، فقد كان العلماء يجرون اختباراتهم منذ القرن التاسع عشر على الأشعة المهبطية والسينية وغيرها من الأشكال المركزة للضوء، حتى اختُرع الليزر (اختصاراً لعبارة: تضخيم الضوء بالإصدار المحَفز للإشعاع) من قِبل ثيودور مايمان في 1960.
فاز جيمس ب. أليسون -وهو رجل من تكساس يحب العزف على الهارمونيكا- بجائزة نوبل للطب مناصفةً مع عالم آخر لهذه السنة؛ وذلك لدوره في استخدام الجهاز المناعي البشري في محاربة السرطان. فقد ابتكر في التسعينيات أساس علاج التسجيل المناعي، والذي يساعد النظام المناعي على التعرف على الخلايا السرطانية، ويمنح الجسم فرصة أكبر للتغلب على المرض.
وعمل أليسون في بداياته كان يعد بدائياً بالنسبة لمعايير التقنيين الحيويين الحالية، فقد نشر بحثاً في 1996 يصف فيه "حصاراً" مناعياً جديداً، وكان البحث في الواقع يقتصر على بعض الفئران والمواد الحيوية التي تم تحليلها، إضافة إلى محقن أو اثنين، أما حالياً فإن العلماء الذين يعملون على مشاكل مماثلة يستخدمون العشرات من الأدوات المختلفة، وذلك وفق ما تقوله أخصائية الأورام ميريام ميراد من مركز ماونت سيناي.
فعلى سبيل المثال تستخدم ميراد مجموعة كبيرة من التقنيات المخصصة للخلايا المنفردة، والتي تسمح لفريقها بتحليل كل خلية على حدة، بدلاً من النسج الأكثر كثافة وتعقيداً، والمؤلَّفة من الكثير من الخلايا. وقد اكتشف الباحثون في هذه العملية معلومات جديدة حول أصغر وأدق سلوكيات الخلية، والتغيرات ما بين الخلايا، أما التصوير متعدِّد المصادر -الذي يعتمد على الجمع ما بين الكثير من الصور للحصول على صورة عالية الدقة- فهو من الأساليب الثورية، ويوماً ما قد يصبح العرض الثلاثي الأبعاد لكل شيء -بدءاً من الخلايا ووصولاً إلى الأورام الكاملة- متاحاً لجميع أخصائيي الأورام.
وتأمل ميراد أن يتم في المستقبل ابتكار جهاز قابل للزرع لتتبع استجابات الجهاز المناعي للمريض في الزمن الحقيقي دون التسبب في أي أذى، أما إيليا شموليفيتش -وهو خبير بالجينات في معهد بيولوجيا الأنظمة- فهو يراهن على تحقيق إنجازات في مجال جمع البيانات، وإدارتها أيضاً، وقد كتب في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لا شك في أننا أصبحنا في حاجة ماسة اليوم إلى أدوات معلوماتية حيوية لمكاملة الكميات الهائلة من البيانات التي يمكن أن نجمعها من المريض، وأعتقد أننا في حاجة إلى تطوير نماذج حاسوبية للبيئة الميكروية للورم، بحيث يمكن استخدام هذه النماذج في تحديد العقار الأفضل أو التشكيلة الأفضل من العقاقير".
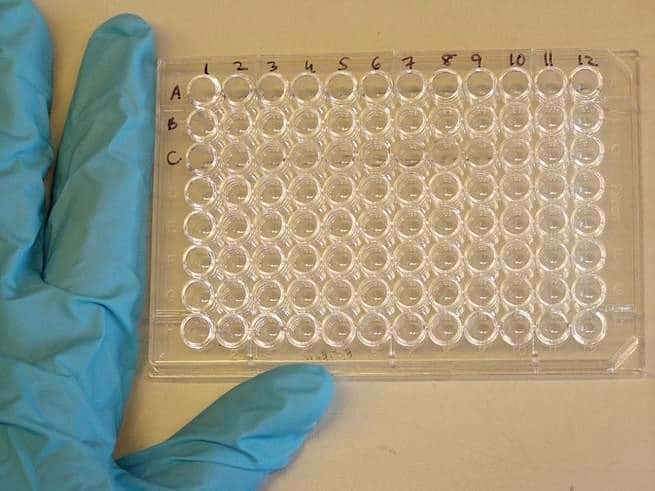
مصدر الصورة: ويكيميديا
تشارك ثلاثة علماء في جائزة نوبل للكيمياء لهذه السنة لابتكارهم بروتينات جديدة، يستطيع بعضها أن يحسِّن الصحة أو يكافح المرض، ويستطيع البعض الآخر أن يخفض من التأثير البيئي لتقنيات التصنيع المستخدمة يومياً.
ومن أشهر المكرَّمين جريج سميث، الذي ابتكر في 1985 طريقة لتطوير بروتينات جديدة باسم عرض الآكلة، وهذه الطريقة تستخدم حالياً على نطاق واسع في الكثير من المختبرات، وهي عملية كثيرة الخطوات للتعامل مع أصغر المواد، ولكنها لا تتطلب سوى الأدوات الكيميائية الأكثر بدائية، أو بصراحة... لا تتطلب إلا أدوات مطبخية: ماء، وصفيحة خاصة، وطبق.
وتتلخص الخطوة الأولى من هذه العملية بوضع البروتينات الواعدة أو المواد الجينية في صفيحة المعايرة الدقيقة؛ وهي صينية صغيرة شهيرة الشكل وكثيرة الفتحات وتستخدم لإجراء التحاليل الكيميائية، وقد ابتكرها طبيب هنغاري في 1951، ولكن لم يتم نشرها على نطاق واسع وإنتاجها بقوالب صناعية إلا في الثمانينيات.
وبعد ذلك يضيف العلماء آكل البكتيريا (وهو فيروس يهاجم البكتيريا)، مما يُجبر الدنا -أو غيرها من المواد- على الظهور، ثم يُوضع الخليط في طبق -أجل... طبق، لقد قرأت الكلمة بشكل صحيح- وتترك المواد حتى تترابط مع بعضها البعض، وعند غسل الطبق في مغسلة المختبر لا تبقى فيه سوى المواد المطلوبة، وحينئذٍ يمكن التلاعب بهذه البقايا وتكبيرها وفق الحاجة، وبالطبع فإن كل شيء ما زال في حاجة إلى التحليل ودراسة الدنا، ولا شك في أن من الضروري أن تتمتع بالمهارة وبالقدرة على الابتكار، وببعض الحظ الجيد؛ وذلك حتى تنتقل من مرحلة غسل الأطباق إلى مرحلة التوصُّل إلى عقار جديد ينقذ الأرواح، ولكن هذه الأدوات الثلاثة -كما قالت لجنة جائزة نوبل- شكَّلت أساس "ثورة مبنية على التطور".