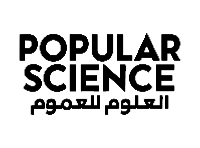تحكم معتقداتنا حول الطبيعة البشرية كل ما نفعله كمجتمع تقريباً. والنظريات المتعلقة بأسئلة مثل «هل الإنسان خيّر أم شرير بطبيعته؟» تؤثر على أحكامنا القضائية. وتؤثر أيضاً النظريات حول أسئلة مثل «هل تتمتع جماعات بشرية بحقوق خاصة تؤثر على سياستنا الاقتصادية. وأخيراً، تؤثر النظريات المتعلقة بأسئلة مثل «هل يولد بعض الأشخاص أذكى من غيرهم؟» و«ما شكل هذا الذكاء؟» على الطريقة التي نعلّم فيها أطفالنا.
يمكن القول أنه لم تسبب أي نظرية شعبية أخرى ضرراً أكبر، وليس هناك نظرية مخطئة أكثر من «البقاء للأصلح». الفكرة القائلة بأن الأفراد الأقوياء وعديمي الرحمة سيستمرون، والضعفاء سيزولون كانت فكرة راسخة في وعينا في الوقت الذي نُشر فيه الإصدار الخامس من كتاب أصل الأنواع الذي ألفه تشارلز دارون عام 1869، والذي كتب فيه -كدفاع عن مصطلح «الانتقاء الطبيعي»-: «بقاء الأصلح هو مصطلح أدق، وأحياناً مناسب بنفس القدر».
ولكن في وقتٍ ما منذ ذلك الحين، أصبح مصطلح «الصلاح» مرادفاً للصلاح الجسدي. في البرية، كل ما كنت أكبر حجماً، وأكثر استعداداً للقتال، قل احتمال أن يتعرض لك أحد وزاد احتمال نجاحك. يمكنك السيطرة على أفضل موارد الطعام، وإيجاد أكثر الشركاء الجنسيين جاذبية، وإنجاب أكبر عدد من الأطفال.
خلال القرن والنصف الأخير، هذا الفهم الخاطئ لـ «الصلاح» مثَّل أساساً للحركات الاجتماعية، وإعادة هيكلة الشركات، والآراء المتطرفة المتعلقة بالسوق الحرّة. واستُخدم هذا المصطلح للمحاججة في صالح التخلص من الحكومات، والحكم على جماعات بشرية بأنها أدنى، ولتبرير الظلم الذي ينتج عن ذلك. ولكن بالنسبة إلى دارون وعلماء الأحياء الآخرين، فإن «بقاء الأصلح» يشير إلى مفهوم دقيق للغاية، وهو القدرة على البقاء وتخليف ذرّية قادرة على البقاء بدورها. وليس من المفترض أن يعمم هذا المفهوم أكثر من ذلك.
فكرة «البقاء للأصلح» كما توجد في المخيلة الشعبية يمكن أن تمثل إستراتيجية بقاء فظيعة. تبين الأبحاث أن كونك الأكبر والأقوى والأقسى يهيئك لحياة مليئة بالضغط. الضغط الاجتماعي يستنزف مخزونك من الطاقة، مما يسبب ضعف الجهاز المناعي وتقليل تعداد الذرية. العدوانية أيضاً مكلفة لأنه القتال يزيد احتمال الأذية أو الموت.
البقاء للألطف أم البقاء للأصلح
نميل لأن نفكر بالتطور كقصة خلق. شيء حدث مرة منذ زمن طويل، واستمر بشكل خطّي. لكن التطور ليس تسلسلاً مرتباً من أشكال الحياة التي تتقدم باتجاه «مثالية» الإنسان العاقل. تعتبر العديد من الأنواع الأخرى أنجح منا. إذ أنها استمرت لمدد أطول بملايين السنين منا، وأنتجت عشرات الأنواع الأخرى التي لازالت مستمرة ليومنا هذا.
إن تطور نَسَبنا منذ أن انفصلنا عن سلفنا المشترك مع قرود البونوبو والشمبانزي قبل حوالي 6 إلى 9 مليون سنة؛ أنتج عشرات الأنواع الأخرى ضمن جنسنا الخاص، وهو الإنسان. هناك أدلة مستحاثة وفي مادتنا الوراثية تفيد بأنه خلال معظم الـ 200000 إلى 300000 سنة تقريباً التي كنا موجودين فيها، فإننا تشاركنا هذا الكوكب مع 4 أنواع بشرية أخرى على الأقل. بعض هذه الأنواع كانت تملك أدمغة بنفس حجم أدمغتنا أو أكبر منها. إذا كان حجم الدماغ هو المتطلب الأساسي للبقاء، فكان ينبغي أن تكون أنواع الإنسان الأخرى قادرة الازدهار مثلنا. لكن بدلاً من ذلك، فإن تعداد أفراد هذه الأنواع كان قليلاً نسبياً، والتكنولوجيا التي استخدموها، على الرغم من أنها كانت مثيرة للإعجاب مقارنة بالأنواع غير البشرية، إلا أنها ظلت محدودة. وفي مرحلة ما، انقرضت كل هذه الأنواع.
العامل الذي سمح لنا بالازدهار بينما انقرضت الأنواع البشرية الأخرى كان نوعاً من القوة الفكرية الخارقة: شكل خاص من التآلف يدعى بـ «التواصل التعاوني». نحن خبيرون في العمل المشترك مع أشخاص آخرين، حتى لو كانوا غرباء. يمكننا أن نتواصل مع أحد لم نلتق به من قبل حول هدف مشترك، ويمكننا أن نعمل معاً لتحقيق هذا الهدف.
نحن ننمي هذه المهارات حتى قبل أن أن نتعلم المشي والكلام. وهي تمثّل وسيلة لدخول عالم اجتماعي وثقافي معقد. وهي تسمح لنا بربط عقولنا مع عقول الآخرين، وأن نرث معارف أجيال كاملة. هذه المهارات أيضاً هي أساس كل أشكال الثقافة والتعلم، ومن ضمنها لغاتنا المعقدة. هذه الجماعات الكثيفة من البشر المثقفين هي التي اخترعت التكنولوجيا المتفوقة. كان الإنسان العاقل قادراً على الازدهار بينما لم تستطع الأنواع الأخرى الذكية من البشر ذلك لأننا نتفوق في هذا الشكل الخاص من الودّ.
تطوّر هذا الودّ من خلال التأنيس الذاتي. كما كان يعتقد سابقاً، فإن التأنيس عبر الأجيال لا يقلل الذكاء. بل يزيد التآلف. عندما يُستأنس نوع من الحيوانات، فإنه يخضع للعديد من التغيرات التي تبدو غير متعلقة تماماً ببعضها. هذا النمط من التغيرات -والذي يدعى بـ «متلازمة التأنيس»- يمكن أن يظهر في شكل الوجه، أو حجم الأسنان، وتصبّغ أجزاء مختلفة من الجسم أو الشعر. ويمكن أن يتضمن تغيرات في الهرمونات و الدورات الإنجابية والجهاز العصبي. ما اكتشفناه في بحثنا هو أن هذه التغيرات يمكن أن تزيد قدرة النوع على التنسيق والتواصل مع الأنواع الأخرى.
التأنيس ليس فقط نتيجة للانتقاء الاصطناعي الذي يمارسه البشر عن طريق اختيار أي الحيوانات يجب إكثارها. بل هو نتيجة أيضاً للانتقاء الطبيعي. في هذه الحالة، الضغط الانتقائي سيتّجه باتجاه التآلف (الذي يوجّه نحو الأنواع الأخرى أو نوعك الخاص). هذا ما ندعوه بالتأنيس الذاتي. وهو مَنحنا أفضلية احتجناها لننجح بينما انقرضت أنواع البشر الأخرى. حتى الآن، شهدنا هذا التأنيس في نوعنا، وعند الكلاب، وعند أبناء عمومتنا الأقرب، قرود البونوبو.
ومع ازدياد ودّ البشر، أصبحنا قادرين على الانتقال من العيش ضمن جماعات صغيرة تعدادها من 10 إلى 50 فرداً إلى العيش ضمن جماعات أكبر تعدادها يصل إلى المئات أو أكثر. حتى دون أدمغة أكبر حجماً، تمكنت جماعات منسقة أكثر من التفوق بسهولة على الجماعات البشرية الأخرى. حساسيتنا للآخرين سمحت لنا بأن نتعاون ونتواصل بطرق متزايدة التعقيد وضعت قدراتنا الثقافية على مسار جديد. إذ أننا أصبحنا قادرين على الابتكار ومشاركة الابتكارات بسرعة أكبر مع أي نوع آخر. ولم يكن للأنواع البشرية أي فرصة للمنافسة.
لكن لودّنا جانب مظلم. عندما نشعر بأن الجماعة التي نودّها مهددة من مجموعة اجتماعية أخرى، فنحن نصبح قادرين على فصل الجماعة المُهدِّدة من شبكتنا العقلية. مما يسمح لنا بأن نجرد أفراد هذه الجماعة من إنسانيتهم. ويختفي كل من التعاطف والرحمة تماماً. وبعدم القدرة على التعاطف مع الغرباء المهددين، فنصبح غير قادرين على أن نراهم كبشر رفاق لنا، ونصبح قادرين على إظهار أبشع الأشكال من الوحشية. نحن النوع الأرضي الأكثر تسامحاً والأقل رحمة بنفس الوقت.
فرضية التأنيس الذاتي ليست مجرد قصة خلق أخرى. إنها وسيلة فعالة تشير إلى الحلول الحقيقية التي تساعدنا في التخلص من ميلنا لتجريد الآخرين من إنسانيتهم. وهي تمثّل أيضاً إنذاراً وتذكيراً بأنه لنحقق البقاء ونزدهر، فنحن سنحتاج لتوسيع تعريفنا لمن ينتمي لجماعتنا.
هذا المقال مقتبس من كتاب «بقاء الألطف: فهم أصول وإعادة اكتشاف إنسانيتنا المشتركة»، تأليف برايان هير وفينيسا وودز.
هذا المقال محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يُعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً