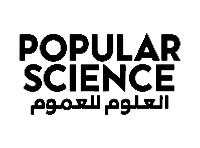على الرغم من أنهم يقولون: "يستحيل التأكد من أي شيء سوى الموت والضرائب"، إلا أن القليل من الشيكات المالية قد يجنبك دفع الضرائب، ولكن لا يمكن لأي قدر من الخداع أن يمنع حتمية الموت؛ فالموت هو نهاية الحياة التي لا مفر منها.
وينطبق هذا الأمر على الأنواع كما ينطبق على الأفراد؛ حيث تشير التقديرات إلى أن 99.99% من الأنواع التي سبق لها العيش على سطح الأرض قد انقرضت الآن، وكافة الأنواع الموجودة اليوم -بما في ذلك البشر- سوف تواجه مصير الانقراض حتماً في مرحلة ما.
ويعرف علماء المتحجرات -مثلي- أن هناك لحظات حاسمة تمر في تاريخ الأرض عندما تكون معدلات الانقراض مرتفعة؛ فقد سبق أن حدد الباحثين مثلاً الموجات الخمس الكبرى للانقراض الجماعي، وهي المرات الخمس التي حدثت خلال نصف مليار سنة أو نحو ذلك، عندما انقرض أكثر من ثلاثة أرباع الأنواع على الكوكب في وقت قصير.
ونحن الآن -ولسوء الحظ- نشهد أيضاً بشكل جلي ومباشر كيف يبدو الانقراض؛ وذلك بسبب الزيادة السريعة في معدلات الانقراض خلال القرن الماضي.
ولكن ما العوامل التي تجعل نوعاً معيناً من الكائنات الحية أقل أو أكثر عرضة للانقراض؟ حيث يختلف معدل الانقراض باختلاف مجموعات الحيوانات وبمرور الزمن، فمن الواضح أن الأنواع لا تتأثر كلها بنفس القدر من عوامل الانقراض، وقد قام العلماء بعمل عظيم عندما وثَّقوا موجات الانقراض، ولكن قد ثبُت أن تحديد العمليات التي تتسبب في الانقراض هو عمل أصعب بعض الشيء.
من الأكثر عرضة للانقراض؟
إن بعض النقاط الحاسمة التي تؤدي إلى انقراض نوعٍ ما تصبح واضحة عندما ننظر إلى الأمثلة الحديثة؛ فأحد هذه العوامل هو انخفاض عدد أفراد النوع، حيث من الممكن أن يؤدي تراجع عدد أفراد نوع معين إلى انخفاض التنوع الجيني، وزيادة إمكانية مواجهة أحداث كارثية عشوائية.
فإن كانت الأعداد المتبقية من أحد الأنواع صغيرة بما فيه الكفاية، فإن حريقاً واحداً من حرائق الغابات، أو حدوث تغيرات عشوائية في النسب بين الجنسين، يمكنه أن يؤدي في النهاية إلى الانقراض.

مصدر الصورة: بانايوتيدي/ Shutterstock.com
وقد حازت موجات الانقراض التي حدثت في الماضي القريب على قدر كبير من الاهتمام؛ كانقراض طائر الدودو أو النمر التسماني أو الحمام المهاجر على سبيل المثال، ولكن الغالبية العظمى من موجات الانقراض حدثت قبل ظهور البشر بفترة طويلة، وبالتالي يعدُّ السجل الأحفوري هو المصدر الرئيسي للبيانات المتعلقة بالانقراض.
وعندما ينظر علماء المتحجرات إلى المستحاثات في سياق ما نعرفه عن البيئات في الماضي، فإنهم يبدأون في تشكيل صورة أوضح عما تسبب في انقراض الأنواع، وحتى الآن ارتبط احتمال تعرض نوع معين للانقراض بمجموعة من العوامل.
ونحن نعلم بالتأكيد أن التغيرات في درجة الحرارة تمثل أحد العناصر الهامة؛ فقد أدى تقريباً كل ارتفاع كبير أو انخفاض كبير في درجات الحرارة العالمية عبر تاريخ الأرض إلى انقراض شريحة من الكائنات الحية المختلفة، كما تُمثل مساحة المنطقة الجغرافية التي يشغلها نوع ما أمراً حاسماً أيضاً؛ فالأنواع الموزعة على نطاق واسع أقل عرضة لمواجهة مصير الانقراض من تلك التي تشغل مساحات صغيرة، أو التي تسكن في مواطن متفرقة.
كما أن هناك ظواهر عشوائية أيضاً تتسبب في الانقراض، وربما يكون أفضل مثال على ذلك هو النيزك المسؤول عن انقراض نحو 75% من أشكال الحياة في نهاية العصر الطباشيري، بما في ذلك الديناصورات غير الطائرة، وهذا الجانب العشوائي للانقراض هو السبب في ذهاب البعض إلى القول بأن "البقاء للأوفر حظاً"، وربما تكون هذه الجملة تعبيراً مجازياً يصف تاريخ الحياة بشكل أفضل من عبارة "البقاء للأصلح".

مصدر الصورة: أطلس عصر النيوجين للحياة القديمة
وقد حدَّدت -في الآونة الأخيرة- أنا وزملائي مكوَّناً فيزيولوجياً للانقراض؛ حيث وجدنا أن معدل الاستقلاب (الأيض) التمثيلي عند كل من أحافير الرخويات والأنواع الحية منها يتنبأ -وبقوة- بإمكانية أن تنقرض، ويعرَّف معدل الاستقلاب هذا بأنه: (متوسط معدل امتصاص الطاقة وتوزيعها عند أفراد النوع الواحد)؛ وبالتالي فإن أنواع الرخويات التي تمتلك معدلات استقلاب مرتفعة تكون مرشحة للانقراض أكثر من تلك التي تمتلك معدلات منخفضة.
بالعودة إلى التعبير المجازي "البقاء للأصلح أو للأوفر حظاً" نجد أن هذه النتيجة تشير إلى أن عبارة "البقاء للأشد كسلاً" قد تصح في بعض الأحيان؛ حيث ترتبط معدلات الاستقلاب المرتفعة بمعدلات الوفيات المرتفعة عند الأفراد في كل من الثدييات وذباب الفاكهة، وبالتالي فقد تمثل هذه العملية وسيلةً هامة لضبط معدل الوفيات على مستويات بيولوجية متعددة.
ولأن معدل الاستقلاب مرتبط بمجموعة من الخصائص -بما في ذلك معدل النمو، وزمن بلوغ النضج، وأقصى مدى للحياة، والحد الأقصى لعدد الأفراد- فيبدو من المرجح أن طبيعة أي من هذه الصفات (أو كلها مجتمعة) يلعب دوراً مهماً في مدى ضعف نوع معين أمام موجات الانقراض.
الكثير من جوانب الانقراض المجهولة
لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه عن العوامل الدافعة إلى الانقراض رغم كل ما توصل إليه العلماء؛ فعلى سبيل المثال تتعرض بعض الأنواع للانقراض دون حدوث أي اضطراب كبير، سواء على الصعيد البيئي أو البيولوجي، وهذا ما يسمى بمعدل الانقراض الطبيعي، وهذا المعدل لم يتم تحديده بصورة كافية، وليس معروفاً تماماً مدى الشدة التي يتقلب وفقها، سواء كانت مرتفعة أو منخفضة، وذلك بسبب أن علماء المتحجرات يميلون إلى التركيز على موجات الانقراض الجماعية، بالرغم من أن معظم موجات الانقراض بشكل عام تنتمي غالبًا إلى هذه الفئة.
والمشكلة الأخرى هي تحديد مدى أهمية التفاعلات البيولوجية المتغيرة في تفسير الانقراض؛ فمثلاً قد يتعرض نوع ما للانقراض عندما تزداد بكثرة أعداد أحد الأنواع المفترسة أو الأنواع المنافسة، أو عندما ينقرض أحد الأنواع المهمة من الفرائس التي يتغذى عليها، ونادراً ما يلتقط السجل الأحفوري هذا النوع من المعلومات.
وحتى عدد الأنواع التي تعرضت للانقراض قد يشكل لغزاً في حد ذاته؛ فنحن لا نعرف سوى معلومات ضئيلة عن التنوع البيولوجي في الماضي أو في الوقت الحالي للكائنات الحية الدقيقة -مثل البكتيريا أو العتائق (البكتيريا القديمة)- ناهيك عن أي شيء عن أنماط الانقراض التي تعرضت لها هذه المجموعات.

مصدر الصورة: درو إيفري
ربما يكون أكبر خطأ قد نقترفه -بخصوص تقييم موجات الانقراض وتفسيرها- هو اتباع نهج واحد يناسب جميع الحالات؛ حيث إن قابلية تعرض أي نوع من الأنواع للانقراض تختلف مع مرور الوقت، كما تختلف الاستجابة للتغيرات البيئية باختلاف المجموعات البيولوجية، وبالرغم من أن التغيرات الكبرى التي شهدها المناخ العالمي قد أدت إلى تعريض بعض المجموعات البيولوجية إلى الانقراض، إلا أن هذه الأحداث نفسها قد أدت في النهاية إلى ظهور العديد من الأنواع الجديدة في مجموعات أخرى.
إذن فإن معرفة مدى قابلية أي نوع من الأنواع للانقراض (سواء بسبب النشاطات البشرية أو التغيرات المناخية المقترنة بها) تظل موضعاً للتساؤل في بعض الأحيان، ومن الواضح أن المعدل الحالي للانقراض يتجاوز بكثير فكرة أن يسمى بالمستوى بالطبيعي، بل هو في طريقه ليكون موجة الانقراض الجماعي السادسة.
وبالتالي يريد العلماء إيجاد إجابة سريعة عن السؤال عن قابلية تعرض أي نوع من الأنواع -بما في ذلك نحن البشر- لموجة انقراض محتملة، هذا إن كان لدينا أي فرصة للحفاظ على التنوع البيولوجي في المستقبل.