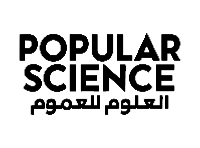تخيل نفسك تحتفل في حفل التخرج من الجامعة، وبجانبك زملائك من الطلبة الشباب الذين يستعدون مثلك للدخول في معترك الحياة الواقعية بعد تلك المرحلة. ما الذي تفكرون به عندما ترفعون قبعاتكم السوداء في الهواء، وتلتقطون الصور التذكارية بعد رحلة طويلة من التعلم؟ ما هو الشيء المميز في الشهادة التي حصلتم عليها؟ تلك الورقة الثمينة التي ترموها في الهواء. هي لا تمثل فقط دليلاً على ما حصلتم عليه من معرفة، بل هي جزء من لعبة السمعة التي تكتسبونها من المكان الذي درستم فيه. فأن تكون خريجاً من جامعة هارفارد مثلاً يكسبك بريقاً أكثر مما لو كنت تخرجت من مؤسساتٍ تعليمية أخرى، أليس كذلك؟ ولكن عند إلقاء نظرة عن كثب إلى هذا الواقع، ستجد أن الحصول على الشهادة أصبح يمثل النهاية المثالية لمأساة التعليم الحديث.
لماذا أقول ذلك؟ لأن الدراسة في الجامعات والمناهج الدراسية مصممة على أساس 3 وحداتٍ أساسية وفقاً للمدرسة الفرنسية الكلاسيكية التي أعتبرها لب المشكلة، وهي: الوقت والعمل والمكان. يلتقي الطلبة في الحرم الجامعي (وحدة المكان)، ويدرسون في الفصول (وحدة العمل)، وجميعهم في العشرينات من عمرهم (وحدة الزمان). في الواقع، سمح هذا النموذج الكلاسيكي دائماً بإنشاء جامعاتٍ مرموقة، لكنه اليوم يواجه تحدياً جديداً بعد توجه المجتمعات نحو الرقمنة، وانتشار التكنولوجيا التي تتيح لكل شخص لديه اتصال بالإنترنت من اكتساب المعرفة التي تتماشى مع العالم سريع التغيّر. ينبغي على الجامعات إدراك أن التعلم في سن العشرينيات لم يعد كافياً، نظراً لأن التكنولوجيا تتغير وتنتشر بشكلٍ أسرع من ذي قبل، وبات على العمال والموظفين تحديث مهاراتهم وتجديدها باستمرار لمواكبة هذا التطور.
التعلّم مدى الحياة
يقول عالم المستقبل الإنجليزي «ريتشارد واتسون»: «يجب تطوير نموذج الجامعات التقليدية نحو نموذجٍ جديد يزود الطلبة بالمهارات المناسبة، والمعرفة اللازمة للمنافسة في عالم باتت فيه القيمة مستمدة بشكلٍ أساسي من التفاعلات بين الناس، ومن القدرة على الابتكار وتحليل الأشياء بشكلٍ لا تستطيع الآلة القيام به». ويتابع قائلاً: «من خلال تدريس المناهج الأساسية والمهارات الحديثة، ستزود الجامعات الطلاب بالمهارات المستقبلية للتعلم مدى الحياة، وليس فقط إعدادهم ليكونوا جاهزين للدخول إلى سوق العمل».
بدأت بعض الجامعات بالفعل في لعب دور مهم في نشر مفهوم التعلم مدى الحياة، انطلاقاً من حرصها على الحفاظ على قيمة شهادتها. يأتي هذا الدور الجديد مع مجموعة ضخمة من التحديات، ويحتاج إلى حدٍ كبير من ابتكار الحلول. قد يتمثل أحد الأساليب للقيام بهذا التحول بتجاوز فكرة الحاجة إلى الدراسة لمدة 5 سنوات للحصول على الإجازة الجامعية، وتبني مناهج دراسية جديدة تفاعلية تستمر مدى الحياة، وهو نموذج نسميه «جواز السفر مدى الحياة».
يمكن أن تكون درجة البكالوريوس جواز سفرك للتعلم مدى الحياة. حيث يحتاج الطلبة في هذه السنوات الأولى لتعلم «كيفية التعلم» فقط، وبالتالي سيمتلكون مهارات التفكير التي ستبقى معهم لبقية حياتهم، وتساعدهم في تحديث معارفهم كلما لزم الأمر. على سبيل المثال، تسمح لك الفيزياء بمراقبة العالم وفهمه، بل والاستفادة من ملاحظاتك بدمجها في نماذج واستخدامها للخروج بنطرياتٍ أو قوانين يمكنها التنبؤ بالمستقبل. كما تفيد علوم الرياضيات في صياغة قوانين الفيزياء أو الاقتصاد، والقيام بعمليات حسابية متطورة تساعد بالتالي في التنبؤ بالمستقبل. يشكل هذان التخصصان الدعائم الأساسية للتعليم في الجامعات التقنية.
في الواقع، دفعتنا التطورات الأخيرة في الأساليب الحسابية وعلوم البيانات لإعادة التفكير في العلوم والهندسة. فأصبحت للحواسيب الدور الأكبر والأساسي في الاستفادة من البيانات وتحليلها من أجل طرح الأسئلة، الأمر الذي يحتاج طرقاً جديدة مختلفةً كلياً في التفكير. لذلك تجب إضافة نظام جديد يمزج بين علوم الكمبيوتر والبرمجة والإحصاء، والتعلم الآلي إلى الموضوعات التأسيسية التقليدية للرياضيات والفيزياء. ستتيح هذه الركائز الثلاثة مواصلة تعلّم المعارف التقنية المعقدة طيلة حياتك، لأن معرفة قواعد الحساب هي المهارة الأساسية التي يبنى عليها كل شيء في نهاية المطاف.
ووفقاً لهذا النموذج الجديد، فإن درجة الماجستير في العلوم ستصبح المرحلة الأولى في رحلة التعلم مدى الحياة. لأن من المفترض أن يقوم منهج الماجستير بتحضير الطلبة لحياتهم المهنية القادمة، من خلال السماح لهم بالتركيز على امتلاك المهارات العملية في إطار تنفيذ المشاريع.
ستتشابك هذه المشاريع بعد ذلك مع المعارف التقنية التي يكتسبها المتعلم وفقاً لرغبته وحاجة المشروع الذي يعمل عليه بسرعة. وعلى سبيل المثال، إذا كان مشروعك عبارة عن تطوير دارة كهربائية متكاملة مثلاً، ستحتاج عندها لدراسة المفاهيم المتطورة في الإلكترونيات الدقيقة، وسيتم تطوير المهارات الأكثر أهمية قبل بدء المشروع في إطار فصولٍ تدريبية تمهيدية، بينما يمكن الحصول على بقية المهارات الأخرى بالتزامن مع تنفيذ المشروع، وهو ما يتيح إمكانية تطبيقها عملياً وبشكل فوري. بالتالي توفير سياقٍ تعليمي غني.
وبالإضافة إلى القدرات التقنية، فإن المشاريع بطبيعتها تسمح بتطوير المهارات الاجتماعية التواصلية والإدارية، مثل مهارة التخطيط واكتساب الخبرة في التصميم، واتخاذ المبادرات وقيادة الفريق، وإعداد التقارير أو تخطيط الموارد. وهذه المهارات لن يتم فقط دمجها عملياً في المنهج، بل سيكون من المهم جداً امتلاكها في المستقبل أيضاً لأنه من الصعب أتمتتها.
وباختصار، ستصبح شهادة ماجستير العلوم الجديدة عبارة عن المشاريع المنجزة وقائمة بالمهارات التقنية المُكتسبة التي تم تعلمها أثناء تنفيذ المشاريع. هذه الحافظة مفتوحة على كل الفرص والاحتمالات في المستقبل، ويجب تحديثها دائماً طيلة الحياة، خاصة وأن التكنولوجيا واستخداماتها تتطور بشكلٍ متسارع.
وبعد نيل درجة الماجستير، سيكون هناك مراحل أخرى عديدة من التعلم مدى الحياة. إذا قررت الجامعات الانخراط في هذا النموذج التعليمي، فستحتاج للتعامل مع العديد من التحديات التنظيمية التي ستهز النموذج التقليدي المبني على وحدة الزمان والمكان والعمل. أولاً: لن يكون بالإمكان التنبؤ بعدد الطلبة الذين سيتبعون هذا النهج. فإذا عاد خريجو تلك الجامعة للدراسة مجدداً، فإن أعداد الطلاب ستكون أكبر بكثير مما هي عليه الآن، وسوف تعجز المباني والإطار التدريسي عن استيعاب هذه الأعداد. ثانياً: سيختلط الطلبة المتخرجون حديثاً مع من أولئك الذين يمتلكون خبرة مهنية عالية، وبالتالي، من شأن ذلك إدخال تغييرات على ديناميكيات الفصل الدراسي، ربما للأفضل. في الواقع، يعكس التعليم المبني على المشاريع -والذي ينطوي على الاختلاط بين المستجدين وأصحاب الخبرة- واقع العالم المهني، وبالتالي فهو قد يكون أفضل إعداداً للعمل.
هل يبدو هذا الأمر مثل أفلام الخيال العلمي؟ في الواقع، لم تعد الدراسة في العديد من الدول بدوامٍ جزئي أمراً استثنائياً، ففي دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بلغت نسبة الطلبة الذين يدرسون جزئياً في الجامعات حوالي 20% من المسجلين في التعليم العالي عام 2016. وهذه النسبة مرتفعة وتتجاوز 40% في دولٍ مثل أستراليا ونيوزيلندا والسويد.
إذا أصبح التعلم مدى الحياة أولوية وقاعدة جديدة، فإن الشهادات العلمية ستصبح مثل جواز السفر، ستخضع للتجديد دورياً. إن ربط هذا التجديد بموعد زمني محدد سوف يسهل إدارة مثل هذه المسائل. ستعرف الجامعات والموظفون وأصحاب هذه الشهادات متى يتعين عليهم تجديد معارفهم وإعادة التدريب. على سبيل المثال، فإن خريجي عام 2000 سيحتاجون للعودة للدراسة مجدداً في العام 2005.
يمكن أن يمثل هذا المقترح حلاً للمصاعب التنظيمية التي قد تواجهها الجامعات، ولكنه ليس حلاً للمتعلمين الذين يواجهون ضغط الوقت والمسؤوليات العائلية، والحاجة لكسب المال. وفي هذا الصدد، قد يكون التعلم عبر الإنترنت خياراً مناسباً لأنه يوفر الوقت الذي تقضيه في التنقل أو السفر. ولكن هذا الحل محدودٌ أيضاً، فحتى الآن، لم يلتزم أحد من مدراء الشركات المتعاملين مع منصات التعلم عن بعد مثل «كورسيرا» و«يوداسيتي» بتوظيف أو حتى مقابلة خريجي هذه البرامج التعليمية الجديدة عبر الإنترنت.
حتى لو لم يكن الوقت مشكلة، فمن سيتحمل تكاليف التعلم مدى الحياة؟ إنه جدال أبدي. هل يجب أن تتحمله الدولة، أم صاحب العمل، أم المتعلم نفسه؟ على سبيل المثال، تتطلب مهن الرعاية الصحية في ولاية ماساتشوستس شهادات التعليم المستمر. ومع ذلك، لا يحتاج محامو الولاية نفسها إلى تعليم قانوني مستمر رغم من أن معظم المحامين يشاركون فيه بشكلٍ غير رسمي. ربما يرجع السبب في ذلك إلى أن مهنة المحاماة لا تتطلب تحديث المعارف كما المهن الأخرى كما في المهن الصحية.
هناك العديد من النماذج في أوروبا، ولكن من المفيد والمثير هنا مقارنة النموذجين الفرنسي والسويسري. ففي فرنسا كل فرد لديه الحق في التعلم مدى الحياة، والذي يُدار من خلال «حساب التعلم الشخصي» الذي يحوي المعارف التي اكتسبتها خلال مسيرتك المهنية. أما في سويسرا فإن التعلم مدى الحياة هو مسؤولية شخصية ولا تتدخل الحكومة فيه. ولكن رؤساء العمل والدولة يشجعون على التعلم المستمر إما من خلال تمويل أجزاءٍ منه -مثل بعض الدورات-، أو السماح للموظفين بحضورها. لقد أصدر معهد «ماكينزي» العالمي تقريراً حول مستقبل الوظائف، جاء فيه أن 89% من الشركات في سويسرا في العام 2015 دعمت فكرة تقديم دورات تدريبية إضافية لعامليها، و 44% من الموظفين في الشركات الصغيرة التي تضم 10 موظفين شاركوا في هذه الدورات التدريبية.
للجامعات الدور الرئيسي في اتباع هذا النهج باعتبار أن التعليم العالي يفترض به أن يؤدي لإحداث التغيير. نحن لا ندعوها إلى إلغاء النموذج الجامعي القديم تماماً، حيث أنه أنتج العديد من المواهب والقيمة للمجتمع، ولكننا ندعو إلى تكييفه مع المستجدات المتسارعة لتلبية الاحتياجات الراهنة التي اختلفت عن السابق.
يمكنكم الاطلاع على النسخة الإنجليزية من المقال من «آيون» من هنا.